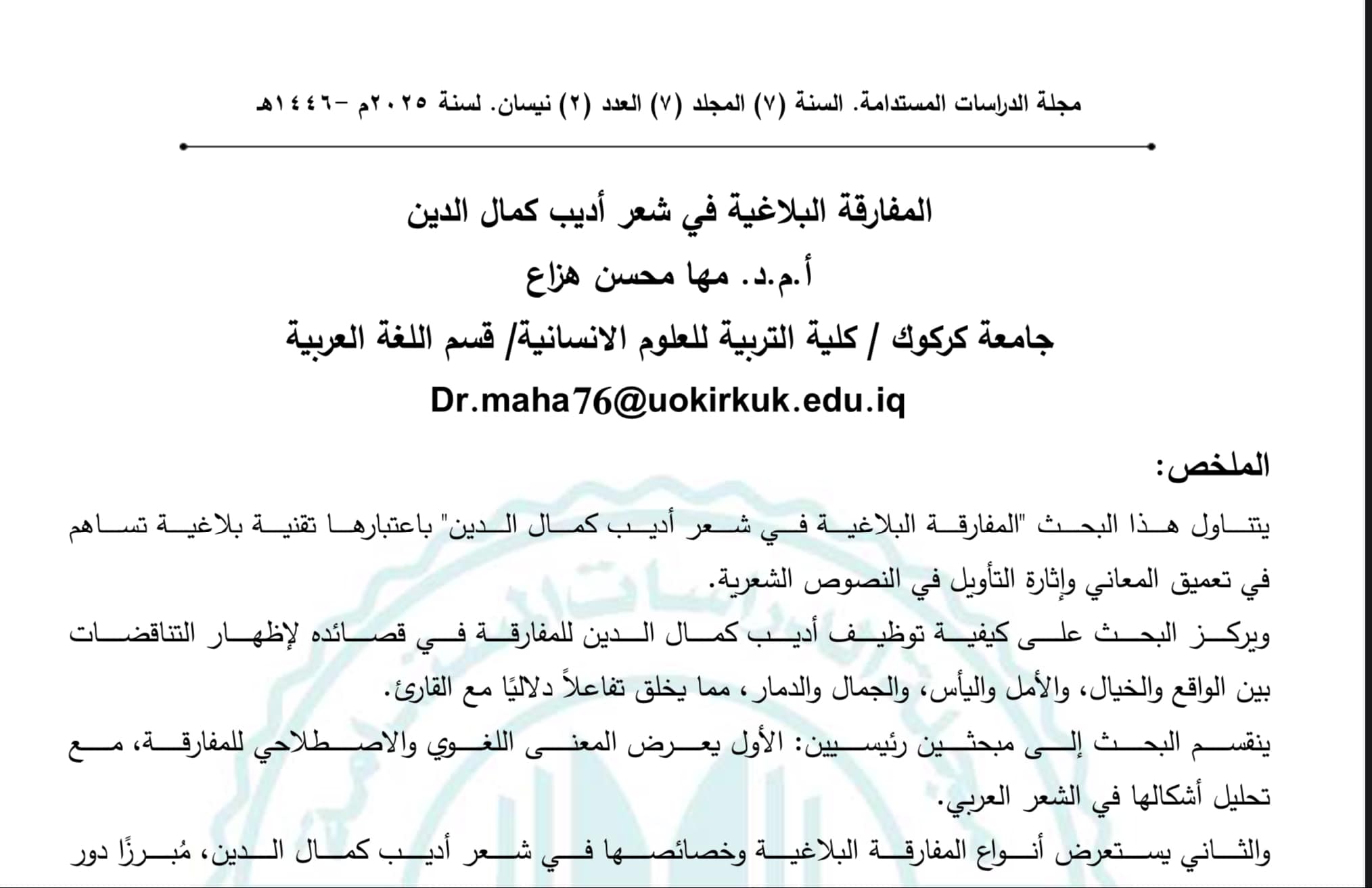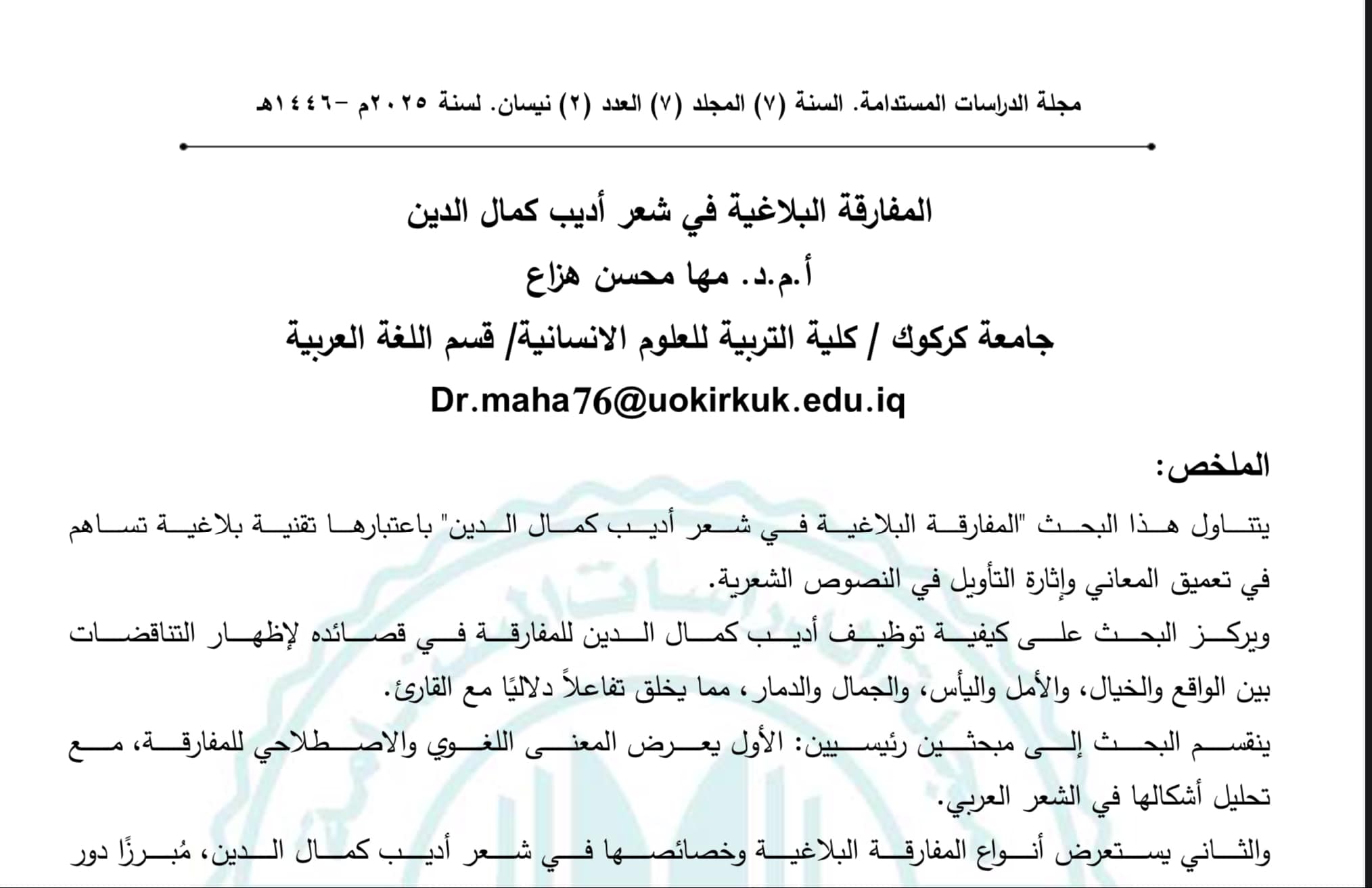|
يتناول هذا
البحث "المفارقة البلاغية في شعر أديب
كمال الدين" باعتبارها تقنية بلاغية
تساهم في تعميق المعاني وإثارة
التأويل في النصوص الشعرية.
ويركز البحث
على كيفية توظيف أديب كمال الدين
للمفارقة في قصائده لإظهار التناقضات
بين الواقع والخيال، والأمل واليأس،
والجمال والدمار، مما يخلق تفاعلاً
دلاليًا مع القارئ.
ينقسم البحث
إلى مبحثين رئيسيين: الأول يعرض
المعنى اللغوي والاصطلاحي للمفارقة،
مع تحليل أشكالها في الشعر العربي.
والثاني يستعرض
أنواع المفارقة البلاغية وخصائصها في
شعر أديب كمال الدين، مُبرزًا دور
المفارقة في تعميق المعاني وتحقيق
التأثير البلاغي. كما يتم تحليل شواهد
من قصائد مثل "بغداد بثياب الدم"،
"صبيّ"، و"محاولة في الموسيقى"، التي
تظهر كيف تساهم المفارقة في إثراء
الأبعاد النفسية والجمالية للنصوص.
خلص البحث إلى
أن المفارقة في شعر أديب كمال الدين
تُعد أداة بلاغية فعالة في التعبير عن
التوترات النفسية والفكرية في
المجتمع، كما تساهم في تجسيد معانٍ
معقدة تعكس الواقع المؤلم والأمل
الضائع.
وتُظهر
المفارقة قدرة الشاعر على توظيف
التناقضات لإبراز حقيقة الواقع
وصراعاته، مما يعزز من قدرة النصوص
على التأثير والإقناع.
الكلمات
المفتاحية: المفارقة البلاغية، شعر
أديب كمال الدين، البلاغة الشعرية،
التأويل، التناقضات، التفاعل الدلالي.
الحمد لله،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
وبعد.. يعدّ الشعر وسيلة فنية رفيعة
تُستخدم للتعبير عن التجارب الإنسانية
بطرق مبتكرة، ويعتبر أديب كمال الدين
من أبرز الشعراء الذين وظفوا التقنيات
البلاغية الحديثة في أعمالهم الشعرية.
من بين هذه
التقنيات البلاغية، تبرز "المفارقة
البلاغية" كأداة فنية تُضفي على
النصوص الشعرية أبعادًا دلالية غنية،
وتُسهم في تعميق المعاني وجعلها أكثر
تأثيرًا.
تتميز المفارقة
في شعر أديب كمال الدين بتوظيفها
البارع للمتناقضات والصور المجازية
التي تثير الفكر وتشعل الخيال.
فهي ليست مجرد
آلية لغوية أو أسلوب فني، بل هي جسر
يمتد بين المعنى الظاهر والباطن،
ويكشف عن التوترات النفسية
والاجتماعية التي يعاني منها الفرد
والمجتمع.
ففي شعر أديب
كمال الدين نجد أن المفارقة لا تقتصر
على الأبعاد اللغوية فقط، بل تتداخل
مع القيم الثقافية والاجتماعية، مما
يجعلها أداة فعالة في إيصال رسائل
متعددة الأبعاد.
تهدف
الدراسة إلى استكشاف المفارقة
البلاغية في شعر أديب كمال الدين،
وتحليل دورها في تشكيل البنية الفنية
للقصائد، فضلاً عن بيان الأغراض
البلاغية التي تسهم المفارقة في
تحقيقها.
ومن خلالها
سنسعى لفهم كيفية تأثير المفارقة في
تعميق المعاني الشعرية، ودورها في
إثراء النصوص بلاغيًا وفنيًا، مما
يعكس سعي الشاعر لاستخدام البلاغة
لإيصال رسائله الإنسانية والفكرية
بطرق مبتكرة.
تعدّ المفارقة
البلاغية من أبرز الأساليب الفنية
التي تثير اهتمام النقاد والدارسين في
مجال البلاغة العربية، لما لها من دور
مهم في تعميق المعاني وتوسيع الأفق
الفكري للنصوص الأدبية.
وتتجسد
المفارقة في تعارض ظاهر بين جزئين من
النص، ما يخلق نوعًا من التوتر
البلاغي الذي يُثير الفكر ويشعل
الخيال، ليكشف عن أبعاد عميقة قد تكون
مغفلة في النصوص التقليدية.
في شعر أديب
كمال الدين، يتجلى هذا التوتر البلاغي
بشكل فني متميز، حيث لا تقتصر
المفارقة على كونها مجرد أداة لغوية،
بل تصبح عنصراً أساسياً في بناء النص
الشعري وتوجيه رسائله.
فالشاعر يدمج
المفارقة في قصائده لتكون أداة تعبير
عن التناقضات الوجودية والنفسية،
وتعكس الواقع المعاش بطرق مبتكرة،
مُعتمِدًا على صوره المجازية التي
تتناغم مع الأبعاد الثقافية
والاجتماعية، مما يمنح شعره بُعدًا
خاصًا يعكس التحولات الفكرية
والتحديات التي يواجهها الإنسان في
الزمن المعاصر.
يُعدّ أديب
كمال الدين من الشعراء الذين تمكنوا
من استثمار المفارقة البلاغية بشكل
عميق، حيث استخدمها ليس فقط لإثارة
الانتباه أو التشويق، بل لخلق فضاءات
شعرية تتسع للتأملات الفلسفية
والوجودية، مما يضفي على أعماله
الشعرية طابعًا مميزًا وأسلوبًا خاصًا
ومن هنا، يأتي
هذا البحث ليتناول المفارقة البلاغية
في شعر أديب كمال الدين، مُركزًا على
الدور الذي تلعبه في تعميق المعاني
وتحقيق الأغراض البلاغية، مع التركيز
على تأثيرها في بناء النصوص الشعرية
وتحقيق الأبعاد النفسية والاجتماعية
المرتبطة بها.
وبدراسة هذا
الموضوع، نتطلع إلى فهم أعمق لأهمية
المفارقة البلاغية كأداة فنية أساسية
في شعر أديب كمال الدين، وفتح باب
الاستكشاف لما تحققه هذه المفارقة من
تأثيرات فنية وبلاغية في نصوصه.
المبحث الأول: مفهوم المفارقة
البلاغية وتجلياتها في شعر أديب كمال
الدين
أولاً: مفهوم المفارقة البلاغية.
المفارقة لغة: "
المفارقة في اللغة من الجذر الثلاثي ف
- ر- ق من المباينة؛ ومنه قوله فَرْقُ
الشَّعْر، والقطيع من الغنم، الذي من
أسمائه في اللغة: الفرق، والفرق أيضًا
الفلق([1])،
قال تعالى:(( فَأَنفَلَقَ فَكَانَ
كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ
الْعَظِيمِ)).([2])
تشير معاجم
اللغة العربية إلى معاني متعددة لكلمة
"المفارقة"، منها ما يرتبط بالتباعد
والانفصال، فإفراق المحموم هو تخلصه
من الحُمَّى، والناقة المُفرق هي التي
فارقها ولدها بعد موته([3])
وكذلك، فإن "الفُرْقان" يُطلق على
كتاب الله الذي يميز بين الحق
والباطل، والصبح يُسمى المفرق لأنه
يفصل بين ظلام الليل وضوء النهار،
وهذه الأمثلة جميعها تُظهر المفارقة
بوصفها عملية تنطوي على الفصل
والمباينة بين طرفين متناقضين أو
متباعدين.([4])
وقد أضاف ابن
منظور في لسان العرب توضيحات دقيقة؛
إذ اعتبر أن "الفَرْق" يرتبط
بالإصلاح، بينما "التفريق" يتجه نحو
الإفساد، كما أوضح أن التفرق
والافتراق متشابهان، لكنهما قد
يُستخدمان في سياقات مختلفة: فالتفرق
يُشير إلى الأبدان، بينما الافتراق
يتعلق بالكلام والأفكار، كذلك فإن
كلمة "الفُرقَة" تُستخدم كاسم يعبر عن
الفعل الحقيقي للابتعاد، بينما
"الفِرْقُ" و"الفِرْقَة" و"الفريق"
جميعها تدل على الطائفة أو المجموعة
المنفصلة عن الكل. أما عبارة "فرق له
عن الشيء" فتعني أوضح له وفصل الأمور
عن بعضها البعض.([5])
تبرز
هذه المعاني الجذرية في المفارقة
البعد البلاغي الغني للمصطلح، حيث
يتضمن فصلًا أو تمييزًا بين طرفين
متعارضين بشكل جوهري، سواء كان هذا
الفصل في الأفكار أو المواقف أو حتى
الأجسام، ويظهر جليًا في أن المفارقة
ليست مجرد حالة لغوية عابرة، بل هي
أداة بلاغية تعكس جدلية قائمة على
التضاد والتنافر، مما يجعلها وسيلة
فعّالة لإبراز التناقضات وخلق دهشة
جمالية في النصوص الأدبية، لا سيما في
الشعر الذي يُعنى بالتكثيف والاختزال
في التعبير عن المعاني المتباينة.
المفارقة
اصطلاحًا: المفارقة البلاغية اصطلاحًا
هي أسلوب أدبي بلاغي يعتمد على
التناقض الظاهري بين المعنى الذي
يقدمه النص أو التعبير بشكل مباشر،
والمعنى الحقيقي الذي يقصده الكاتب أو
الشاعر.([6])
والمفارقة
البلاغية هي عملية لغوية قائمة على
التضاد بين السطح والدلالة العميقة([7])،
حيث يبدو المعنى المباشر مألوفًا أو
متوقعًا، بينما يتجلى المعنى الحقيقي
مفاجئًا أو غير متوقع، ما يخلق حالة
من الدهشة أو الاندهاش لدى المتلقي.([8])
هذا الأسلوب لا
يُستخدم عشوائيًا، بل يأتي لتحقيق
غايات متعددة مثل السخرية، أو
الانتقاد، أو تعزيز الجمالية البلاغية
للنصوص، والمفارقة تعمل كجسر بين
الظاهر والباطن، بحيث تقود القارئ إلى
تجاوز ما يبدو بسيطًا أو مألوفًا
لاستكشاف ما هو معقد ومشحون
بالدلالات.([9])
ثانياً: أنواع المفارقة البلاغية
وخصائصها.
تتسم المفارقة
البلاغية بتعدد أنواعها وأشكالها، وهي
نتيجة تطور طويل للمفهوم، سواء في
التراث الغربي أو العربي، مما أضفى
عليها خصائص متنوعة جعلتها أداة غنية
للتعبير الأدبي والبلاغي، ويمكن تقسيم
المفارقة إلى عدة أنواع رئيسية، يجمع
بينها قدرتها على خلق التباين بين
المعنى الظاهري والباطني، مع التركيز
على التأثير الفكري والجمالي في
المتلقي.([10])
أنواع المفارقة
الادبية البلاغية:
1.
المفارقة اللفظية
تعتمد على وجود
معنى ظاهر يخالف المعنى المقصود، حيث
تُقدَّم العبارات بشكل يحمل دلالة
مضللة أو مضادة لما يراد منها، ومن
أمثلتها مفارقة العنوان، والمفارقة
البيانية كالتشبيه
والاستعارة والكناية.
هذا النوع من
المفارقة هو الأكثر شيوعًا في النصوص
الأدبية، تقوم المفارقة اللفظية على
تقديم معنى سطحي للعبارات يخالف
المعنى المقصود أو الخفي الذي يسعى
الكاتب إلى إبرازه، تستخدم هذه
المفارقة غالبًا لتوليد التوتر أو
السخرية من خلال التناقض بين الكلمات
ومعانيها.([11])
مثال: قول
أحدهم في وصف وضع مأساوي: "يا له من
يوم جميل!"، حيث تبدو العبارة
إيجابية، لكنها تحمل في طياتها سخرية
مريرة.([12])
2.
المفارقة السياقية
تظهر في
الأحداث أو المواقف التي تخالف
التوقعات، حيث يُظهر النص تناقضًا بين
ما ينتظره القارئ أو الشخصيات وبين ما
يحدث فعليًا، هذا النوع يخلق عنصر
المفاجأة، مما يعزز من تأثير النص
ويضيف إليه بعدًا دراميًا أو ساخرًا،
مثال: شخصية تسعى طوال الرواية لتحقيق
هدف معين، لكنها تكتشف في النهاية أنه
كان وهميًا أو غير ذي قيمة.([13])
أشكالها:
1.
مفارقة الموقف، ومنها التناقض بين
الفعل ونتيجته.
2.
مفارقة الحدث، كوقوع حدث غير متوقع
يؤدي إلى نتيجة مغايرة للتوقعات.
3.
مفارقة التناقض الداخلي، كتناقض داخل
الشخصية نفسها بين ما تؤمن به وما
تفعله.
المفارقة
السياقية تعكس عبثية الواقع أحيانًا،
حيث تقدم الحياة مفارقات تجعل القارئ
يعيد النظر في فهمه للأحداث ولطبيعة
الإنسان.([14])
3.
المفارقة التراجيدية
تبرز في النصوص
التي تحتوي على نهايات مأساوية غير
متوقعة، تضفي شعورًا بالدهشة أو الحزن
العميق، ويتميز هذا النوع بالجمع بين
الألم والمفارقة، حيث تظهر التناقضات
في نصوص درامية أو مأساوية لتعكس
عبثية القدر أو المصير، والمفارقة
التراجيدية تجعل المتلقي يشعر بالأسى
والدهشة في آنٍ واحد،إذ يلاحظ أن
الشخصيات غير واعية بالتناقض الذي
يقودها إلى نهايتها الحتمية، مثال:
البطل الذي يحاول إنقاذ أحبته لكنه
يؤدي دون قصد إلى هلاكهم.([15])
خصائصها تتمثل
في:
·
البعد الإنساني الذي يجسد صراعات
البشر مع القدر.
·
الحتمية التي تشير إلى أن النهاية
المأساوية نتيجة حتمية لسوء الفهم أو
القرارات الخاطئة.
·
تسليط الضوء على هشاشة الإنسان أمام
الأقدار، مما يجعل النصوص التي توظفها
تثير مشاعر عميقة في نفس القارئ.([16])
4.
المفارقة الساخرة
تستخدم للسخرية
أو التهكم من خلال الإشارة إلى
تناقضات في القيم أو السلوكيات أو
الأفكار، والمفارقة الساخرة تهدف إلى
الانتقاد أو التهكم من خلال إبراز
التناقضات بين ما يُقال وما يُقصد،
وهذا النوع من المفارقة يُستخدم عادةً
في الأدب الساخر للنيل من العادات
الاجتماعية أو الأخطاء البشرية.([17])
مثال: كاتب
يسخر من غياب العدالة قائلاً: "إنه
زمن العدالة المطلقة حيث يُعاقب
الفقير بصرامة وينجو الغني!".
أشكالها:
·
السخرية المباشرة، كتقديم التناقض
بشكل واضح للقارئ.
·
السخرية الرمزية، كاستخدام الرموز
والإيحاءات للتعبير عن المفارقة.
·
السخرية السياسية، كنقد الأوضاع
السياسية أو الاجتماعية باستخدام
التهكم.
والمفارقة
الساخرة تمنح النصوص حيوية وعمقًا
فكريًا، حيث تثير أسئلة جوهرية حول
القيم والمبادئ المتعارف عليها.([18])
خصائص المفارقة
البلاغية
1.
التناقض المزدوج، حيث تجمع بين
مستويين دلاليين، الأول يشير إلى
الترابط أو الاندماج بين المتناقضات،
والثاني يشير إلى افتراقها أو
تمايزها، مما يجعلها أداة لتحليل
العلاقة الجدلية بين المعاني.
2.
التفاعل بين السطح والعمق، المفارقة
تقدم ظاهرًا يحمل توقعات محددة، لكنها
تتلاعب بهذا الظاهر لتكشف عن عمق
مغاير، مما يضفي طابعًا إبداعيًا على
النص.
3.
الترابط بين الموروث والمعاصر، ظهرت
جذور المفارقة في الثقافة الفلسفية
اليونانية (كلمة Paradox)،
التي تعني معارضة الرأي الشائع، لكنها
تطورت في العصر الحديث لتشمل معاني
متنوعة مثل السخرية، والتناقض،
والتلاعب بالتوقعات.([19])
4.
تعدد الأشكال والأساليب، تنقسم
المفارقة إلى أشكال متنوعة تتراوح بين
المفارقة اللفظية البسيطة، والمفارقة
الفلسفية العميقة، مما يجعلها أداة
شاملة للتعبير عن الأفكار المتناقضة.
تمثل
المفارقة البلاغية أداةً مركزيةً في
الأدب والنقد، حيث تجمع بين العمق
الفكري والجمالية الفنية، إن الأنواع
المختلفة للمفارقة لا تعكس فقط التنوع
في الطرق التعبيرية، بل تسلط الضوء
على قدرة النصوص على نقل رسائل متعددة
المعاني، مما يحفز المتلقي على
التفكير والتأمل، المفارقة ليست مجرد
وسيلة لغوية، بل هي تعبير عن
التناقضات التي تشكل الواقع الإنساني
ذاته، وتجعل من الأدب مجالًا لإعادة
تشكيل الرؤى والمواقف.
المبحث الثاني: أثر المفارقة البلاغية
على بنية النص ومعانيه في شعر أديب
كمال الدين
أولاً: أثر المفارقة البلاغية على
البنية الفنية لشعر أديب كمال الدين.
ونجد اثر
المفارقة البلاغية في قصيدة (بغداد
بثياب الدم) بقولهِ:
"وحين طلبتْ
جرعةَ ماء
أعطوها قنبلةً
للموتِ وسيفاً للذبح
وحين طلبتْ
رغيفَ خبز
أعطوها رمحاً
من نار".([20])
تتجلى المفارقة
البلاغية في التناقض الصارخ بين ما
تطلبه بغداد (الحاجات الأساسية
للحياة: الماء والخبز) وما يُقدَّم
لها (أدوات الموت والدمار)، وهذا
التضاد يعكس القسوة واللامبالاة تجاه
معاناة المدينة، مما يولّد شعورًا
بالعجز والمرارة.
وتظهر المفارقة
_هنا_ على شكل استعارات متوالية في
النص من مثل "جرعة ماء" و"رغيف خبز"
وهي إن كانت في ظاهرها بحث عن القوت
اليومي للانسان سداً للرمق الا انها
استعارة للحقوق البسيطة والأساسية
التي تحتاجها بغداد (رمز الإنسان أو
الوطن)، ويسعف المعنى ذاته ويكمله
قوله "قنبلة للموت" و"سيفاً للذبح" إذ
يمثلان استعارة للعدوان والقسوة بدلًا
من تلبية الاحتياجات الأساسية، فضلاً
عن انه لم يكتفِ بالافتقار الى
الحاجات الاساسية بل استمر مناقضاً
للسلام (اسم آخر لبغداد) حد المبالغة
، ففي قوله "رمحاً من نار" استعارة
تعبر عن العنف المفرط والدمار الموجه
ضد طلب السلام.
كما وتتجلى فيه
الكناية في متوالية آخرى للمفارقة
لتعاضد معنى الاستعارة في قوله "طلبت
جرعة ماء" و"طلبت رغيف
خبز" و "أعطوها قنبلة للموت" وهي
كنايات عن الاحتياج البسيط للحياة
والكرامة والسعي نحو العيش الكريم
فضلاً عن الرد القاسي والمدمر تجاههم.
وكذلك في
القصيدة نفسها (بغداد بثياب الدم)
نجده يقول:
"وحين طلبتْ
شمساً
صادوا شمسَ
الله
حتّى لا تحضر
يوماً ما
لشوارع بغداد".([21])
فالمفارقة
البلاغية في التناقض بين طلب بغداد
لشمس ترمز للنور والأمل، وبين صيد
الشمس ومنعها من الحضور، يُبرز عبثية
وقسوة الواقع، حيث يتحوّل مطلب الحياة
الطبيعي إلى شيء يُجرَّم ويُعاقب عليه
في صورة استعارية رائعة في
قوله "طلبت شمساً" بحثاً عن الأمل و
النور والعدالة في الحياة، تقابلها
صورة استعارية آخرى في قوله "صادوا
شمس الله" لتعبر عن محاربة الخير
والضياء أو منع الأمل عن بغداد، مما
يوحي بالقهر والظلم، متحدة مع الصورة
الكنائية في ( الرغبة في حياة مشرقة
مليئة بالأمل والحرية)، مقابل صورة
(الظلم والاستبداد الذي يحرم الناس من
حقوقهم الأساسية).
وأيضاً في
القصيدة ذاتها رصدنا مفارقة آخرى يقول
فيها:
"قالوا: عن أيّ
طبيبٍ تتحدثُ هذي المسكينة؟!".([22])
المفارقة
البلاغية -هنا- في استخدام لفظ
"المسكينة" للتعبير عن مدينة عظيمة
مثل بغداد، بينما يُنكر وجود الطبيب
أو من يهتم بها، مما يعكس السخرية
السوداء من حجم الإهمال والتجاهل الذي
تعانيه المدينة.
وفي تلك
القصيدة الطويلة يختتم قائلاً:
"الطبيبُ مشغول
بالخليفة
والخليفة مصاب
منذ ألف سنة
بالمللِ
التاريخيّ
والمللِ
الجغرافيّ
والمللِ
الروحيّ
والمللِ
الأمنيّ
والمللِ
الجنسيّ".([23])
فالمفارقة
البلاغية في السخرية –هنا- تتجسد في
وصف الخليفة المصاب بـ "الملل"
المتعدد الأوجه بينما تُترك بغداد
تنزف دون علاج. المفارقة تبرز التناقض
بين انشغال السلطة بالترف والتفاهة
وبين معاناة الشعب للحقيقية القائمة
على المفارقة البيانية
بالاستعارة في قوله "الطبيب
مشغول بالخليفة" وهي استعارة تشير إلى
أن من يُفترض أن يكون حاملاً
للمسؤولية (الطبيب) مهووس بخدمة
السلطة (الخليفة) بدلًا من علاج الأمة
(بغداد)، أما عبارة "الخليفة مصاب"
فهي استعارة تجسد الحالة السياسية
والإنسانية للقيادة على أنها مرض
مستعصٍ، كما نجد في قوله "الملل
التاريخي والجغرافي والروحي والأمني
والجنسي" كناية عن
الجمود التام الذي أصاب كل جوانب
الحياة نتيجة سوء الإدارة والفساد،
وتكرار كلمة "الملل" يعكس الإحساس
العميق بالركود والتكرار الممل
للأخطاء عبر الزمن، وكذا السخرية
اللاذعة تظهر في وصف الخليفة بأنه
مصاب بكل أنواع "الملل"، مما يعكس
انتقادًا قويًا للقيادة التي تفتقر
للحيوية والرؤية.
وفي قصيدته
الطويلة الأخرى (صبيّ) يقول :
"لم أجد
الطائرَ العملاق
لم أجد حتّى
اسمَ الطائر
لم أجد الجمهور
لم أجد حتّى
ذلك الصبيّ
الذي هو أنا".([24])
البلاغية نجد
المفارقة في تضاد مؤلم بين البحث عن
ذكريات الطفولة والصدام مع الواقع
الذي ينكر حتى وجود "الصبيّ" الذي كان
يومًا ذو كيان، والمفارقة هنا تعكس
فقدان الهوية والاغتراب النفسي عبر
الزمن من خلال صور استعارية في
قوله "الطائر العملاق" استعارة تمثل
الطموح الكبير أو الحلم الضائع الذي
يسعى إليه الشاعر، أما في قوله "اسم
الطائر" استعارة تعبر عن فقدان القدرة
على تحديد معالم ذلك الطموح أو الحلم
وأيضاً في قوله "ذلك الصبيّ الذي هو
أنا" استعارة تمثل الذات الأصلية
للشاعر التي فقدها نتيجة التحولات
الزمنية أو التجارب الحياتية.
وكذا نجد
الكناية والتكرار في قوله "لم أجد
الجمهور" كناية عن غياب
الدعم أو الانتماء أو الشعور بالعزلة
الاجتماعية، فتكرار عبارة "لم أجد"
يعزز الإحساس بالخيبة والبحث العبثي
الذي لا ينتهي، وكأنه يحاول اضفاء جو
من التواصل بين مقاطع القصيدة([25])
والشاعر يترك
العديد من الرموز مثل "الطائر"
و"الجمهور" و"الصبيّ" مفتوحة للتأويل،
مما يمنح النص عمقًا ويعزز الشعور
بالغموض والضياع.
وفي قصيدة
(محاولة في الموسيقى) الذي يقول
فيه:
"الموسيقى
تهبطُ تهبط
طيراً وعنقودَ
عنبٍ وشلال ماء
فيطيرُ قلبي مع
الطير
لكنّ يدي لا
تمسكه".([26])
نجد المفارقة
البلاغية بين الشعور بالجمال
(الموسيقى والطير والعنقود) وبين عدم
القدرة على التفاعل الجسدي معه، وهذا
التناقض يجسد العجز عن تحقيق التواصل
الكامل مع الجمال الروحي أو الحياة
المثالية في تشبيه مركب لطيف بليغ حيث
غيب (الاداة ووجه الشبه) من النص في
قوله "الموسيقى تهبط طيراً وعنقودَ
عنبٍ وشلال ماء" الموسيقى هنا تُشبه
بالطير (الحرية والخفة)، وعنقود العنب
(اللذة والجمال)، وشلال الماء
(الحيوية والانسياب)، وهذه التشبيهات
تجسد الموسيقى كظاهرة متعددة الأبعاد،
تجمع بين البهجة والجمال والحيوية.
أما في قوله
"يطير قلبي مع الطير" استعارة جميلة
تعبر عن انسجام الشاعر العاطفي مع
الموسيقى وشعوره بالتحليق الروحي.
وكذا الكناية
في قوله "لكنّ يدي لا تمسكه": كناية
عن عدم قدرة الشاعر على امتلاك أو
احتواء الجمال الكامل للموسيقى، فهي
تظل تجربة روحية وعاطفية يصعب الإمساك
بها ماديًا، والإيحاء بأن الموسيقى
تمثل تجربة عابرة وسامية، تجمع بين
الجمال الحسي والروحي، لكنها تظل غير
ملموسة أو قابلة للإمساك، فالنص
استخدم الاستعارة والتشبيه والكناية
لخلق صورة حسية وروحية متكاملة عن
تجربة الموسيقى، مؤكدًا جمالها
وسموها، وفي الوقت ذاته إحساس العجز
عن احتوائها.
وفي قصيدة
(محاولة في الموسيقى) نجده
يقول:
"السعادةُ
راقصةُ بالية
والحزنُ بدويّ يفترشُ الأرض
ليعزف على الربابة"([27])
فالمفارقة
البلاغية تتجلى في تشبيه (السعادة)
وهي تتلاشى بسرعة براقصة الباليه التي
ترمز إلى الرقي والخفة وهو فن راقٍ
ومؤقت، بينما (الحزن) يُشبَّه ببدويّ
بطبيعته البسيطة و الثابتة، يعزف على
الربابة راسخاً كحقيقة دائمة،
والتناقض –هنا- يبرز هشاشة السعادة
مقارنة بعمق واستمرارية الألم.
وكذلك
يقول فيها:
"حتّى الحروف
صارتْ تتعبني
فهي الوحيدة
التي تزورني في وحشتي الكبرى
دون أن تحمل في
يدها باقة شمس
أو حفنة قمر
أو قبلات ريش".([28])
المفارقة
البلاغية في الحروف التي من المفترض
أن تكون وسيلة التعبير والمواساة،
تتحوّل إلى عبء يُرهق الشاعر،
والتناقض بين وظيفتها المفترضة
وحقيقتها في النص يعكس مدى الوحدة
والاغتراب الذي يشعر به.([29])
ففي
قوله "الحروف صارت تتعبني" استعارة
تعبر عن ثقل الكتابة أو الكلمات على
نفس الشاعر، حيث لم تعد وسيلة للتعبير
بل مصدرًا للإرهاق.
وكذلك من
المفارقة البيانية قوله "تزورني في
وحشتي الكبرى" كناية عن الشعور العميق
بالوحدة والعزلة.
أما عبارة "دون
أن تحمل..." كناية عن عدم قدرة
الكلمات على جلب الفرح أو الإلهام
للشاعر.
فضلاً عن
التشبيه الضمني بين الحروف التي تأتي
بلا "باقة شمس" أو "حفنة قمر" وبين
الزائر الذي يزور بلا هدية أو بشائر،
مما يوحي بخيبة الأمل.
فالحروف التي
من المفترض أن تكون وسيلة للتواصل
والإلهام تتحول إلى عبء، مما يخلق
مفارقة مؤلمة تضاعف من إحساس الشاعر
بالعزلة، والشاعر يجعل من الحروف
شخصية فاعلة في وحدته، لكنها عاجزة عن
تخفيفها. فالصور البلاغية تعكس بعمق
الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر،
وتجعل من الوحدة تجربة حسية نابضة
بالمشاعر.
وأيضًا في
قوله:
"الموسيقى
تهبطُ بلاماتٍ عذبةٍ كشفاه الأطفال
وراءاتٍ تزقزقُ
وسيناتٍ توسوس
وندى من
نونات".([30])
فالمفارقة
البلاغية تكمن في صورة الموسيقى التي
تصف جماليات الحروف بصور بهيجة
(عذوبة، زقزقة، وسوسة) تتناقض مع
إحساس الشاعر بفقدان السكينة
الداخلية، مما يجعل الجمال ظاهريًا
فقط وغير قادر على معالجة الجراح
الحقيقية، ومما ساهم في هذا المعنى
استخدامه لفن التشبيه في قوله
"بلاماتٍ عذبةٍ كشفاه الأطفال": بصورة
مباشرة صريحة حيث شُبهت "اللامات
العذبة" برقة ونعومة شفاه الأطفال،
مما يضفي على الموسيقى صفات البراءة
والجمال.
وكذلك نجد
الاستعارة في قوله "راءات تزقزق" حيث
شبه الحروف "الراء" بطيور تزقزق، في
صورة حسية توحي بالحيوية والفرح،
و"سينات توسوس" بتشبيه "السينات"
بالأصوات التي توسوس، مما يعكس الهدوء
والرقة في الموسيقى، أما قوله "ونادى
من نونات": استعارة تصور "النونات"
كصوت نداء يعبر عن الحميمية أو النداء
العاطفي.
فضلاً عن
الكناية عن تنوع الأصوات التي تصنع
الموسيقى بجمالها وثرائها.
هذه الشواهد
تعكس العمق الفكري والفني الذي
يستخدمه أديب كمال الدين في بناء
نصوصه. فالمفارقة البلاغية تظهر كعنصر
أساسي في تشكيل بنية قصائده، ولا سيما
فن الاستعارة الذي هيمن على نصوصه
والتي تعد بدورها من مقتضيات النظم
وتتخذ اساليب كثيرة لسعة بابها ودقة
مسلكها وسحر تشكيلها([31])
مما يعزّز إحساس
القارئ بالازدواجية بين الجمال
والحزن، الأمل واليأس، الحقيقة
والوهم، والمفارقة البلاغية في نصوص
أديب كمال الدين ليست مجرد أداة فنية،
بل هي انعكاس للواقع المأساوي
والمتناقض، إنها تبرز الأبعاد الرمزية
والفلسفية لنصوصه، حيث تتداخل السخرية
مع الحزن لتجعل المتلقي يعيد النظر في
الواقع والوجود الإنساني.
ثانياً: دور المفارقة في تعميق
المعاني وإثارة التأويل
في قصائد أديب
كمال الدين، تتنوع المفارقة البلاغية
بين اللفظية والموقفية، مما يضيف
عمقًا وتجاذبًا في المعاني التي
يطرحها.
ففي قصيدته
"بغداد بثياب الدم"، يُظهر الشاعر
مفارقة لفظية عندما يبين التناقض بين
طلب بغداد البسيط للماء والجواب الذي
تلقته بالقنبلة وسيف الذبح.
وهذه المفارقة
تعكس قسوة الواقع وعبثية الوضع، مما
يثير التأمل في التفريق بين الحاجات
الإنسانية البسيطة والردود
اللاإنسانية التي يتلقاها سكان
المدينة، كما أن هذه المفارقة تعمق
المعنى بشكل فلسفي، مما يجعل القارئ
يتساءل عن معاني الإنسانية والعدالة
في عالم غيّبته الأهواء.
وفي السياق
نفسه، تظهر مفارقة لفظية أخرى في
القصيدة نفسها عندما يعبر الشاعر عن
الحزن والألم في جمل مثل "تعبتْ بغداد
من ثيابِ الدم" و"نزفتْ موتاً أحمر
كجهنم"، حيث يُدمج الألم والدم في
صورة معبرة عن حالة من الانكسار في
المدينة التي لا تجد من يخفف عنها.
وهذا يعمق
الفهم من خلال تسليط الضوء على
التباين بين العذابات التي تعيشها
بغداد وأيضًا كيف يتم تجاهل معاناتها
في العالم الخارجي.
وتظهر المفارقة
الموقفية في القصيدة ذاتها عندما
يتحدث الشاعر عن بغداد التي تطلب
الطبيب فيُقال لها: "الطبيب مشغول
بالخليفة"، مما يشير إلى تجاهل حاجة
المدينة لمساعدة طبية في وقت الأزمات،
وهذه المفارقة تبرز العبثية التامة في
التعامل مع معاناة بغداد وتعكس فقدان
المسؤولين للوعي بما تمر به المدينة
من ويلات، كما تُعمق من التفكير حول
العلاقة بين الزمن والتاريخ وكيفية
تأثير السياسات على حياة الناس.
في قصيدة
"الموسيقى تهبطُ تهبط"، يظهر نوع آخر
من المفارقة اللفظية في الصورة
الشعرية المزدوجة بين الجمال
والمأساة، يتناقض الشاعر بين موسيقى
هابطة تُصور الطير والعنب والشلال،
وبين المعاناة الشخصية التي يكشف عنها
عندما "أصطدم بصخرته الكبيرة" ويغرق،
وهذه المفارقة تشير إلى التباين بين
الجمال الظاهر الذي لا يستطيع الشاعر
التمسك به وبين واقعه المأساوي الذي
يحاصر كل شيء جميل في حياته.
أخيرًا، تأتي
مفارقة لفظية أخرى في تصوير الشاعر
للسعادة والحزن في قصيدته التي قال
بها "السعادةُ راقصةُ بالية والحزنُ
بدويّ يفترشُ الأرض". المفارقة هنا
تظهر التناقض بين السعادة الزائلة
والحزن الثابت، مما يعزز رؤية العالم
المظلم، حيث يتفوق الحزن على السعادة
ويظل يُسهم في زيادة الضغط النفسي على
الشاعر، هذه المفارقة تساعد في تعميق
الفهم حول العلاقة بين المظاهر
السطحية للفرح وبين واقع الألم الذي
يعيشه الشاعر وإذا ما أردنا أن نجمع
الأغراض التي خدمتها المفارقة
البلاغية في شعره سنجدها كالتالي:
1.
العبثية واللاعدالة، حيث تمثل
المفارقات في الشواهد حالات من
التناقض بين احتياجات الإنسان البسيطة
والأجوبة القاسية، مما يعكس غياب
العدالة والمساواة.
2.
التفريق بين الحقيقة والباطل، بعض
المفارقات تتعلق بالتمييز بين ما هو
حقيقي وما هو زائف أو مغلوط، مما يعمق
المعنى الفلسفي للأحداث.
3.
التشاؤم والإنكار، تظهر المفارقات
دلالات على إنكار الواقع والتهرب من
المعاناة، مما يؤدي إلى تفاقم حالة
التشاؤم في النص.
4.
العبثية في السياسة والمجتمع، هناك
أيضًا مفارقات تظهر الواقع المؤلم
للمدن والشعوب التي تعاني من إهمال أو
تجاهل الحكومات.
5.
التناقض بين الجمال والمأساة، حيث
يُظهر الشاعر التباين بين الجمال الذي
يعجز عن الحلول والتدخل في المعاناة
النفسية والوجودية.
6.
التأكيد على الفقد والضياع، حيث تعكس
المفارقات الفقد الشخصي والتشتت بين
الذاكرة والمكان في صور الشعر.
7.
التباين بين الجمال والدمار، فقد
استعمل المفارقات لربط الجمال بالدمار
والفقد، مما يعكس الحالة النفسية
للشاعر في مواجهته للمجتمع والواقع.
8.
التمزق بين الفرد والمجتمع، فقد وجدنا
المفارقات في بعض الأحيان تعكس حالة
من التمزق بين الفرد والمجتمع، أو بين
أحلام الفرد وواقع المعاناة الذي
يعيشه.
9.
الصراع بين الأمل واليأس، فبعض
المفارقات تعكس التنازع بين الأمل
الذي يسعى الإنسان وراءه واليأس الذي
يسيطر عليه.
10.
التحدي والرفض: هناك مفارقات تبرز رفض
الشاعر للواقع والظروف القاسية من
خلال تمسكه برؤيته الشخصية للعالم.
وهذه
الأغراض تتداخل وتتكامل في الشواهد
لتعميق المعاني وإثارة التأويلات لدى
القارئ.
الخاتمة
في ختام هذا
البحث، نجد أن المفارقة البلاغية تمثل
عنصرًا جوهريًا في شعر أديب كمال
الدين، حيث استخدمها الشاعر بمهارة
فائقة لتعبير عن التناقضات الوجودية
والإنسانية، ولإثراء المعاني وتوسيع
آفاق الفهم النقدي للنصوص الشعرية،
فقد استخدم الشاعر المفارقة لتجسيد
التوترات النفسية والداخلية التي
يعاني منها الإنسان
ومن خلال
تقنيات المفارقة، استطاع أديب كمال
الدين أن يخلق مساحة للتأمل والتفاعل
العاطفي والفكري لدى القارئ، مما جعل
شعره يحمل طابعًا خاصًا ومميزًا
يتجاوز البعد الفني ليصل إلى الأبعاد
النفسية والفلسفية التي تسبر أغوار
الوجود، حيث أظهرت المفارقة قدرتها
على تعزيز البنية الدلالية للنصوص
الشعرية، مما أضفى عليها أبعادًا
فكرية ونفسية، فضلاً عن أنها عكست
التوترات التي يعيشها الإنسان بين
الأمل واليأس، الحياة والموت،
والإيمان والتشكيك.
لقد تمكّن
الشاعر من توظيف المفارقة في سياقات
متنوعة، سواء في تجسيد الصراع الداخلي
أو في إبراز التوترات بين الواقع
والطموح، وبين الذات والعالم، إذ فتحت
المفارقة آفاقًا متعددة للتفسير، مما
ساهم في تفاعل القارئ مع النصوص بشكل
أكثر عمقًا، و حفزت القارئ على
التفكير والتأمل، مما عزز دوره كشريك
في فهم النصوص
شكلت المفارقة
أداة لطرح تساؤلات وجودية وفلسفية ضمن
قالب شعري وأضفت على نصوصه الشعرية
دلالات متعددة، ما جعلها محملة برسائل
عميقة تتعلق بالحياة والموت، الألم
والأمل، والإيمان والتشكيك.
ومن خلال هذا
البحث، تبين لنا كيف أن المفارقة
البلاغية في شعر أديب كمال الدين لم
تكن مجرد أداة بلاغية سطحية، بل كانت
حجر الزاوية في بناء النصوص الشعرية
وتوجيه رسائل الشاعر إلى المتلقي، إذ
ساهمت المفارقة في تكثيف اللغة
الشعرية وخلق صور فنية مبتكرة لدى
الشاعر، وذلك بتطوير بنية النصوص
الشعرية فقد شكلت المفارقة عنصرًا
فاعلًا في بناء نصوصه، مما جعلها أكثر
قوة وترابطًا وهذا ما
يجعل شعره واحدًا من أبرز الأعمال
التي تلامس قلوب القارئين وتثير
أسئلتهم حول معنى الحياة والوجود.
فضلاً عن أنها عكست مشكلات وتناقضات
العصر بأسلوب بلاغي مميز ومؤثر،
وأظهرت براعة الشاعر في استخدام أدوات
بلاغية متنوعة لخلق نصوص ذات طابع
فريد.
وفي الختام،
نأمل أن يكون هذا البحث قد ساهم في
تسليط الضوء على دور المفارقة
البلاغية في شعر أديب كمال الدين، وأن
يكون نقطة انطلاق لدراسات أعمق في فهم
كيفية تأثير الأدوات البلاغية في خلق
النصوص الشعرية وتوجيهها نحو الأبعاد
الفكرية والفلسفية التي تلامس الواقع
المعاصر.
الهوامش
([1])
ينظر: ابن فارس: مقاييس اللغة
مادة ف ر ق، وابن منظور: لسان
العرب.
([2])
سورة الشعراء: الآية ٦٣.
([3])
أبو لبن، زياد، في قضايا
النقد والأدب، دار ورد للنشر
و التوزيع، القاهرة، مصر،
2006م، ج1، ص 146.
([4])
خوشناو، نوزاد حمد عمر،
المفارقة في شعر بلند
الحيدري، دار الغيداء للنشر
والتوزيع، 2017م، 1/ 99.
([5])
الفراهيدي، كتاب العين،
تحقيق: مهدي المخزومي
وابراهيم السامرائي، دار
الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
5/147.
([6])
ينظر:
الشين،
فوزية طاهر، الشواهد البلاغية
وتوظيفها، دار البشير للنشر
والتوزيع، القاهرة، مصر،
2013م، ج1، ص105.
([7])
ينظر: غنيم، كمال أحمد، عناصر
الإبداع الفني، دار ورد للنشر
والتوزيع، القاهرة، مصر،
2006م، ج1، ص30.
([8])
الخضيري، المفارقة في النثر
العباسي، مجلة جامعة أم القرى
لعلوم اللغات وآدابها، ع9،
۲۰۱۲م،
ص ٢٥٠
([9])
خضير، عبد الهادي، المفارقة
في شعر المتنبي، مجلة المورد،
وزارة الثقافة والإعلام دائرة
الشئون الثقافية، ج ٣٥، العدد
الأول، ۲۰۰۸م، ص ٦٠.
([10])
العمري، حسين، الخطاب في نهج
البلاغة - بنيته وأنماطه
ومستوياته، دار الكتب
العلمية، بيروت، لبنان،
2010م، ج1، ص70.
([11])
صالح، نوال، جماليات المفارقة
في الشعر العربي المعاصر:
دراسة نقدية، 2016م، ج1، ص 26.
([12])
سليمان، خالد، المفارقة
والأدب: دراسات في النظرية
والتطبيق، دار الشروق للنشر
والتوزيع، القاهرة، مصر،
1999م، ج1، ص 26.
([13])
ينظر:
بودوخة،
مسعود، الأسلوبية و البلاغة
العربية مفاربة جمالية، مركز
الكتاب الاكاديمي، 2017م، ج1،
ص80.
([14])
شبانة، ناصر،
المفارقة
في الشعر العربي الحديث،
المؤسسة العربية للدراسات
والنشر والتوزيع، القاهرة،
مصر، 2002م، ج1، ص 29.
([15])
السيد، وجيه يعقوب، النقد
ومقاربة النصوص الإشكالية،
دار البشير للنشر والتوزيع،
القاهرة، مصر، 2020م، ج1،
ص54.
([16])
يوسف، أحمد، البلاغة
العربية.. قراءة القراءة، دار
الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
2018م، ج1، ص24.
([17])
البخيتاوي، عماد محمد، مناهج
البحث البلاغي عند العرب:
دراسة في الأسس المعرفية،
2012م، ج1، ص 270.
([18])
العبد، محمد، المفارقة
القرآنية: دراسة في بنية
الدلالة، الأكاديمية الحديثة
للكتاب الجامعي، 2013م، ج1،
ص34.
([19])
حماد، حسن محمد، المفارقة في
النص الروائي، المجلس الأعلى
للثقافة، القاهرة، مصر، 2005
م، ج1، ص 150.
([20])
كمال الدين، أديب، الأعمال
الشعرية الكاملة، منشورات
ضفاف للنشر والتوزيع، 2012م،
ج3، ص124.
([21])
كمال الدين، أديب، الأعمال
الشعرية الكاملة، ج3، ص125.
([22])
المرجع السابق، ج3، ص129.
([23])
كمال الدين، أديب، الأعمال
الشعرية الكاملة، ج3، ص127.
([24])
كمال الدين، أديب، الأعمال
الشعرية الكاملة، ج3، ص204.
([25])
الاسترجاع في الشعر العربي
(محمود درويش انموذجاً)، نرجس
خلف أسعد، مجلة جامعة كركوك
للدراسات الانسانية، مج3 ،ع1
،2008، ص219.
([26])
كمال الدين، أديب، الأعمال
الشعرية الكاملة، ج3، ص218.
([27])
كمال الدين، أديب، الأعمال
الشعرية الكاملة، ج3، ص219.
([28])
المرجع السابق، ج3، ص219.
([29])
كمال الدين، أديب، شعرية
الفضاء عند أديب كمال الدين:
قراءة تأويلية، مؤسسة أبجد
للترجمة والنشر والتوزيع،
2011م، ج1، ص75.
([30])
كمال الدين، أديب، الأعمال
الشعرية الكاملة، ج3، ص218.
([31])
ينظر:الاسلوب في أسرار
البلاغة،د. توفيق ابراهيم
صالح، مجلة جامعة كركوك
للدراسات الانسانية، مج3، ع1،
2008، ص2.
المراجع والمصادر
1.
القرآن
الكريم
2.
أبو لبن،
زياد، في قضايا النقد والأدب،
دار ورد للنشر والتوزيع،
القاهرة، مصر، 2006م.
3.
ابن فارس:
مقاييس اللغة مادة ف ر ق،
وابن منظور: لسان العرب.
4.
بودوخة،
مسعود، الأسلوبية والبلاغة
العربية مفاربة جمالية، مركز
الكتاب الأكاديمي، 2017م.
5.
البخيتاوي، عماد محمد، مناهج
البحث البلاغي عند العرب:
دراسة في الأسس المعرفية،
2012م.
6.
الخضيري،
المفارقة في النثر العباسي،
مجلة جامعة أم القرى لعلوم
اللغات وآدابها، ع9،
۲۰۱۲م.
7.
السيد،
وجيه يعقوب، النقد ومقاربة
النصوص الإشكالية، دار البشير
للنشر والتوزيع، القاهرة،
مصر، 2020م.
8.
الشين،
فوزية طاهر، الشواهد البلاغية
وتوظيفها، دار البشير للنشر
والتوزيع، القاهرة، مصر،
2013م.
9.
العبد،
محمد، المفارقة القرآنية:
دراسة في بنية الدلالة،
الأكاديمية الحديثة للكتاب
الجامعي، 2013م.
10.
العمري،
حسين، الخطاب في نهج البلاغة
- بنيته وأنماطه ومستوياته،
دار الكتب العلمية، بيروت،
لبنان، 2010م.
11.
الفراهيدي، كتاب العين،
تحقيق: مهدي المخزومي
وابراهيم السامرائي، دار
الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
12.
حماد، حسن
محمد، المفارقة في النص
الروائي، المجلس الأعلى
للثقافة، القاهرة، مصر، 2005
م.
13.
خضير، عبد
الهادي، المفارقة في شعر
المتنبي، مجلة المورد، وزارة
الثقافة والإعلام دائرة
الشئون الثقافية، ج ٣٥، العدد
الأول،
۲۰۰۸م.
14.
خوشناو،
نوزاد حمد عمر، المفارقة في
شعر بلند الحيدري، دار
الغيداء للنشر والتوزيع،
2017م.
15.
سليمان،
خالد، المفارقة والأدب:
دراسات في النظرية والتطبيق،
دار الشروق للنشر والتوزيع،
القاهرة، مصر، 1999م.
16.
شبانة،
ناصر، المفارقة في الشعر
العربي الحديث، المؤسسة
العربية للدراسات والنشر
والتوزيع، القاهرة، مصر،
2002م.
17.
صالح،
نوال، جماليات المفارقة في
الشعر العربي المعاصر: دراسة
نقدية، 2016م.
18.
غنيم،
كمال أحمد، عناصر الإبداع
الفني، دار ورد للنشر
والتوزيع، القاهرة، مصر،
2006م.
19.
كمال
الدين، أديب، الأعمال الشعرية
الكاملة، منشورات ضفاف للنشر
والتوزيع، 2012م.
20.
كمال
الدين، أديب، شعرية الفضاء
عند أديب كمال الدين: قراءة
تأويلية، مؤسسة أبجد للتوزيع،
2011م.
21.
يوسف،
أحمد، البلاغة العربية..
قراءة القراءة، دار الكتب
العلمية، بيروت، لبنان،
2018م.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
نُشرت في مجلة
الدراسات المستدامة - العدد 2
المجلد 7 نيسان 2025.
|