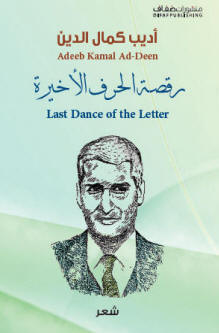قبل خمس من السنوات وقعت بين يدي
مجموعة للمبدع أديب كمال الدين
تحت عنوان "ما قبل الحرف.. ما بعد
النقطة". كانت مهداة منه لصديقي
الشاعر عبد الأمير خليل مراد،
وللوهلة الأولى أيقنتُ أنني اقرأ
شعراً عذباً واني أطالع تجربة
مريرة بدأت وسط مخاض سياسي
واجتماعي عسير أجبرت الشاعر على
ترك الوطن مكرها، لم أكن أحفل
كثيراً بما حصل عليه من شهادات
علمية لأنني لو جمعتها كلها لا
تعادل أيقونة شعرية أطلقها مداد
كمال الدين وهي تترصد الوجع
الإنساني، نعم فالشهادات لا تساوي
شيئاً في ظلّ الإبداع الثر،
وواصلت قراءة المجموعة التي
استعرتها من صديقي الشاعر عبد
الأمير خليل ثمّ تساءلت مَن هو
كمال الدين هذه القامة الشعرية
الباذخة؟ قالوا: شاعر عقّه الوطن
فهاجر وتذوّق مرارة الغربة فازداد
ألقاً وتفتّقت قريحته لحنا سحريا
امتزج مع الواقع أغنية فراتية
شجية، وهذا هو ديدن المبدعين
يمطرون الأرض لتزداد زهواً
واخضراراً حتّى لو حمل الوطن في
قلبه أمكنة وأزمنة وأتراب وغاب عن
عينيه، بأساليب تهيمن على المتلقي
حتّى يردد في خاطره (الله...
الله... كم جميل هذا القول) أو
ليس هذا غرض الشعر؟ ولسنا بحاجة
لمتابعة أحاجي أو حلّ كلمات
متقاطعة كما يحصل اليوم للكثير من
المنتج الشعري الهش.
وحينما يحلق الشاعر في سموات
الإبداع يراه القراء نجماً ويشير
لمعطاه حتّى الحاسدين، وفي إصدار
جديد للشاعر الاديب أديب كمال
الدين عراقي القلب والمشاعر
أسترالي الغربة تحت عنوان (رقصة
الحرف الأخيرة) وهو من منشورات
ضفاف في بيروت، تمنيت أن تقع بين
يدي نسخة من هذه المجموعة فتكّرم
صديقي أديب كمال الدين بإهدائي
نسخة وصلتني عبر البريد الرسمي
إلى مكتبي فاعتبرتها أثمن ما
وصلني من الهدايا خلال عام2015،
وبدأت قراءتها منذ وصولها لأدوّن
انطباعي فلست مدعيا النقد إلا
أنني أقول بوجهة نظري في ما أقرأ
فلا يهدى لي منتج إبداعي إلا
وقرأته بمحبه غير آبه بأمر نقد
هذا اليوم والذي غالبا ما يغور في
مصطلحية أعجمية لا يفهم منها
المتلقي مقصد الناقد ولا رؤيته،
ويكفي أنني أحاول عرض ما اقرأ على
ذائقتي .
وبما أن الشعر أسمى أساليب
التعبير وأجمله ما حسن لفظه
ومعناه معا فلن أخرج عن هذا
الزعم، فبين اللفظ والمعنى قد
يضيّع الشاعر شاعريته من هنا
فارتباط اللفظ الحسن بالمعنى يشكل
لوحة زخرفيه أخاذة تعمّر طويلا في
مخيلة المتلقي، ويطول خزنها في
الذاكرة بل ينشط استحضارها في
الوقت يريده المتلقي فتراه يستشهد
بما استلذ من شعر في وقت يتطلب
فيه تدعيم فكرة معينة أو رأي،
وهكذا اعتاد العرب تطريز أحاديثهم
بحليّ من الشعر لتستقر في القلوب
.
ومن خلال قراءة أولية ل(رقصة
الحرف الأخيرة) نتلمس عذوبة في
اللفظ والمعنى الذي أصرّ الشاعر
على التوأمة بينهما، ليرسم لنا
اللوحة المتخيلة من أبعادها
الأربعة، وهذا ما تصعب قراءته على
الكثير من شعراء اليوم فلو تمكّن
شاعر من تجسيد صورة ما، فسيقرأها
من نقطة رصده فكم سيكون الجهد
مضاعفا لو مرّ ببقية النقاط كي لا
يدع ركنا من الصورة معتم؟
ما دمتَ قد متَّ منذ زمنٍ طويل
واسترحتَ في موتِكَ الأسطوريّ،
فلماذا تحاولُ أنْ تخرجَ أصابعكَ
مِن القبر
كلّما مَطَرَت السماء؟ ص19
لقد ارتبط الموت بالحياة في
هذا النص واحتمل الكثير من
التأويلات الممكنة منها: رغبة
الأموات العود للحياة ثانية
لأسباب مختلفة تؤل " دينية :
ليفعل ما يستحق المكافأة/ تأكيد
حقيقة الحياة بعد الموت/ اجتماعية
: ليكمل ما قطعه الموت عن إتمامه
اجتماعياً / أسطورية : لتؤكد ما
ورد في بعض الأساطير ... أما من
ناحية المفردة فلا غرائبية لغة
سلسة يسيرة ومعبرة والزمان الماضي
الوارد في الفعلين " متَ،
استرحتَ/ مطلقين في الماضوية لا
يمكن تحديدهما زمانيا ولعل إطلاق
الزمان يفيد التعميم والشمول جاءا
بصيغة المفرد والمراد عدد غير
محدد من الأموات. وتلك من الصيغ
الدالة على بلاغة القول ولازمة
الحروفية في شعر كمال الدين أضفت
عليه جمالية دون أن تقحمه في
مناطق تقاطع مع معنى الحرف فقد
استطاع بذكاء أدراك أبعاد كل حرف
ومدياته ووظفه كما يوظف الزخرفي
الحرفَ في لوحته فجاء مرسوماً
بريشة ماهرة ارتقت به لما هو أجمل
يقول:
بسرعةٍ أطلقتُ النارَ على حاء
الحنين
فأصبتُ مِنها مَقْتَلاً،
لأنني لا أملكُ ما أحنُّ إليه:
الفرات وقد تجاهلني،
ودجلة لم تتعرّفْ عليّ،
وكلكامش لم أجده في المتحف
كما كانَ الوعد. ص 47
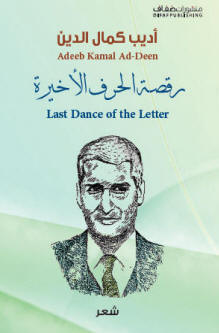
لمَ أطلق النار على حاء
الحنين يجيب نزفا يسترق الأجفان،
ملاعب الصبا والشباب الرفقة
والصور الجميلة كلها مهشمة لاشيء
يدعو للحنين، كم من الذكريات قد
استنطقت هذه الصورة فوجدتها شبه
ميتة أو مهملة وجاء إطلاق النار
كنتيجة بعدية وليس قبلية كما يفعل
من قبل ذلك العرب.
اختصر الشاعر في هذه الجمل
المكتنزة بالمعاني ما يطول شرحه
فحقق الإدهاش وأجاب على أكوام
الأسئلة التي ربما سيطرحها
المتلقي حول أسباب قتل الحاء
فقال" المدن خراب/ النفوس يائسة /
الفرات مكفهر وخرف / ودجلة خائفة
من المجهول / وكلكامش حطمته عجلة
الموت فصار أثرا بعد عين / أكل
هذا قاله كمال الدين؟ لا وبعد قال
الأدهى والأمر قال حوادث الأيام
وفساد الحياة نتج عنه تجاهل
الجمال والاستهانة بالإبداع وهو
صورة فوتغرافية لاشك في وضوحها في
بلادنا اليوم في ظل سيادة كل رديء
مع إهمال متعمد للمميز.
ولو
انتقلنا لدلالة لفظية جديدة في
نص" القصيدة الأنوية" ص89 من
المجموعة لوجدنا أن انتظام
الأنوية قد انطلقت من قاعدة الزمن
البعيد باتجاه الحاضر مؤسسة
لعلاقة من نوع يختلف من حيث
المخرجات النهائية، فمرّة من
"طاغية أرعن" وشكلّت أنا السياسي
السائد في عوالمنا ، وأخرى من
المطرب لتستقر في " صفير وصراخ
المعجبات المراهقات" وتلك أنا
المبدع كان المغني مثلا وثالثة
لصراع بين الأزمنة الثلاثة
وأبلغها التاريخية التي قرأت يوسف
وإخوته انطلاقا من مجموعة أنواة
الإخوة، لأنا يعقوب المفجوع
مرّتين: مرّة بفساد وطمع الأولاد
وأخرى بفقد يوسف يقول:
قالَ إخوةُ يوسف: إنّا نحن، إنّا
أنا.
وألقوا يوسفَ في البئر،
ومضوا لأبيهم بدمٍ كَذِبٍ.
فبكى يعقوبُ أناه
حتّى ابيضّتْ عيناه. ص 93
ستنطق الشاعر الأنا بصيغ مختلفة
كلها واردة في اللغة بيد أن
توظيفها بهذه الصيغ مدعاة للإدهاش
فـ (إنّا، أنا) جَمعَ وأفردْ وذاك
دلالة على أن الأنا قد تشترك مع
أنواة جمعية لتحقق فعلاً للفرد
مرة و للجماعة منطلقة من أنا
المفرد، وقوله في المقطع ما قبل
الأخير " فبكى أناه" تحتمل
الدلالتين معا هي أن يوسف يمثّل
أنا يعقوب أو الأمر متعلّق بيعقوب
وأناه ، مما يدفع بالمتلقي عنوة
لاختيار ما يراه مناسباً بين
الرأيين وهذا بحد ذاته دالة على
حنكة ذكاء المعنى جاء من خلاله
إيجاد المعادل بين دلالة النص
عنده ودلالته عند متلقيه ، فتمركز
الأنوية في "أنا" الموجّهة
علاماتياً، تستجيب للمؤثرين معا
وتسعى لإحداث فجوة في الكينونتين
"مفرداً"،أو "جمعا" بين ثم
يلتقيان في أفق واحد مساحته الـ
"أنا"، لتشكل مفصلا مهما من مفاصل
تركيب الصورة المغايرة للصور
المماثلة وهنا استجد بعد تاريخي
ديني في الاستخدام اللغوي
والمعنوي وفق الشاعر في إيصاله
بأسلوب مثالي.
وليقيني بأن الإحاطة بمضامين
هذه المجموعة أمر عسير لأنها تمثل
صرخات بطعم جنوني وفي كل صرخة
منها طعم ولون، لكني سأحطّ في نص
ما قبل الأخير منها، وأحاوره وفق
ما أراه فهو ترنيمات شجية وصيحات
ناقم على عرف عرفناه للناس ولم
نحتفظ بمعانيه بما يشكل كذبة
مفضوحة كلنا يتستر على استمرارها
يقول:
صفّق الجمهورُ الأبلهُ للعرضِ
طويلاً
وكتمَ رغباته الوحشيّة
في هدوء مُزيّف. ص 130
ويحيلني هذا النص لقاعدة يعمل
بموجبها الرجل الشرقي تحديداً فهو
يبدي الوقار والهدوء والعقلانية
وفي نفسه أسد هصور جامح نحو
التعري ما أن يستنهض حتّى يخرج عن
جبته الكارتونية ووقاره المتصنع،
ويعبر عن جنوح وجموح اللذة بروح
مستلبة وشعور خارج عن الإرادة .
ثم يقول في موضع آخر :
لا معنى للرقصة،
فالراقصة ألهبت المسرح
وأشعلتْ أجسادَ الجمهورِ ووساوسهم
المُرّة. ص 131
وفي هذا تفسير لجهل سلوك
المتعة والقفز على مراحلها حيث
افتقدت الرقصة لمعناها وانصرفت
الرغبة للجسد، وإن لم يصرّح
الرجال باشتعالهم فقد حولهم الجسد
لرماد قبل اختتام التعبيرات
الراقصة . ويزداد الجمهور تفاعلاً
حيث يقول:
اشتدَّ تصفيقُ الجمهورِ للتعرّي
وهو يزدادُ أكثر فأكثر.
ثم يزداد الكشف عن المضمر حيث
يقول:
كانَ نفاقُ الجمهورِ المُتحضّرِ
مُلوّناً
بألوان قوس قزح!
عموما فأنّ مجموعة (رقصة
الحرف الأخيرة) أشارت لحقيقة
التواصل الروحي بين الشاعر وبين
جذوره الثقافية وموروثه الذي لم
يتنكر له كما فعل البعض ممن
"تأمرك أو تهلند أو تسترل...!!"،
توافق الشاعر الأصيل أديب كمال
الدين مع معطاه وأوقفنا أمام
حقيقة ثقافته العضوية التي ما
شابها الخلط والتأثر السلبي مع
ثقافة الآخر. نعم أخذ الشاعر ما
سمى بشاعريته وفقاً لأسّ ثقافته
وهذه الإشارات الايجابية تضع
تجربته أمام البحث الجاد كضرورة
لما جسدته من صدق في التعبير
ومواكبة لأساليب الشعر الحديث ولا
أقصد تلك الأساليب المبتذلة التي
ساقها البعض في نصوصهم وهم
يتنكرون لجذورهم التاريخية ممن
استبدلوا وجوههم بأقنعة البلدان
التي استوطنوها، نصفق من أرواحنا
لعذوبة ما جادت به قريحة الشاعر
والمثقف العضوي العراقي الأصيل
أديب كمال الدين متأملاً من
الباحثين عن ثراء التجارب
الشعرية، وليس المنقبين عن أسماء
كبالونات الهواء لم يبقَ منها سوى
الأسماء أن يتعقبوا نتاجه خدمة
للثقافة العراقية الباذخة، فأديب
مكتنز أدباً ومسكون بالشعر.
تمنياتي له بالمزيد من التقدم
والعطاء وإثراء مكتبة العرب
الشعرية واعتذر لوقوفي الخجل أمام
قامته المعطاء وإيجازي.