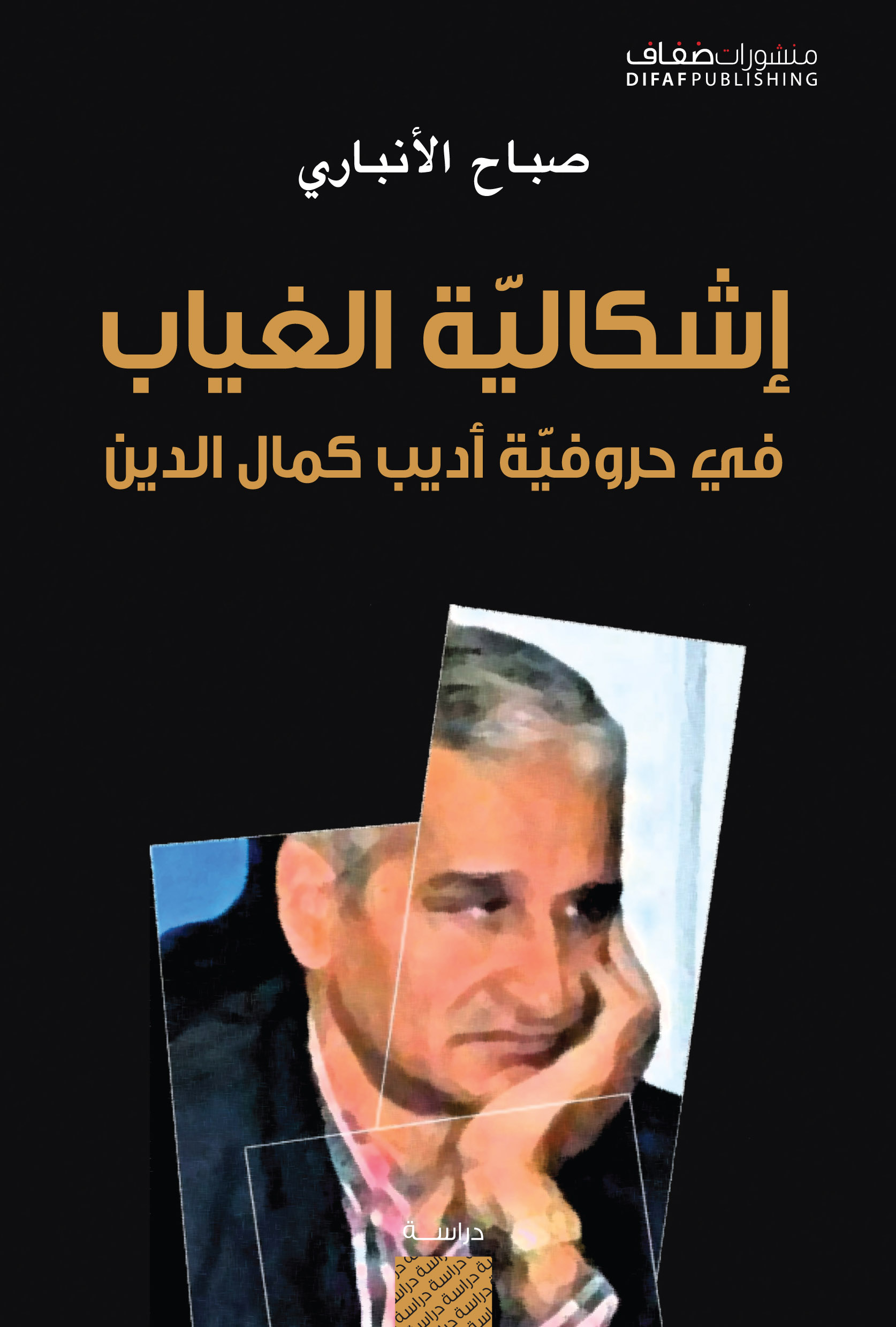في
كتابه ( إشكاليّة الغياب في
حروفيّة أديب كمال الدين )،
الصادر في مطلع عام 2014 عن دار
ضفاف، يقدم لنا صباح الأنباري
صورة قريبة للشاعر أديب كمال
الدين. وأقول قريبة لأنه من جيله
أولا. ولأنه يتقاطع معه في بعض
التفاصيل ثانيا. ومنها الجغرافيا
والخلفيات الثقافية.
وكانت مقدمة سعد محمد رحيم للكتاب
بمثابة إغلاق لهذه الدائرة. ففي
التوطئة التي جاءت بعنوان (
أن
تكتب
بمحبّة ) وضع يده
على المفاصل الأساسية في تجربة
الشاعر والناقد وبلغة كخيوط
الشمس.. مشعة ودافئة.
ولكن هنا لا بد من الإشارة لنقطتي
نظام.
يعتقد رحيم في
مقدمته أن لأديب كمال الدين دورا
مشابها لدور السياب في الشعر (
ص9). هذا بالمعنى العريض والواسع
للعبارة. ولكن أرى أن حياة السياب
مرت بمحطات كثيرة ومنعطفات. في
السياسة انتقل من الشيء لنقيضه.
وفي الشعر ابتعد عن مفهوم الدائرة
المغلقة التي تعبر عن وحدة الجوهر
وتآلف المتناهي مع اللامتناهي.
وبدأ بالشعر العمودي ثم انتقل
لقصيدة حرة لا تتكرر فيها
التفعيلة بانضباط وربما لذلك أجد
أنه أقرب لمفهوم اللامنتمي وليس
الحداثة.
نقطة النظام الثانية وأسميها
شائعة التصوف عند كمال الدين (
ص14). لقد انتشرت هذه الفكرة
كالشرارة في الهشيم بالاستناد
لتراكيب ومفردات لعب بها المتصوفة
للتعبير عن محنتهم مع الخالق
والسلطان الجائر وعلاقة النفس
بالمجتمع. بينما قصائد أديب كمال
الدين تربط اللاشعور الفردي
بأسبابه. وتقترب من الخط الذي
يفصل بين الإيمان و السخط. وكما
نعلم لا يوجد عتاب ولا ممانعة في
جوهر المخيلة الصوفية. إنها تجربة
تقوم على الخنوع والتفاني. بينما
كانت قصائد كمال الدين تتدرج من
الملاحظة وحتى الهجاء وبمنطق فوق
واقعي. ولكن مع تصورات عن تجارب
شخصية. وقد لاحظ الأنباري هذه
الظاهرة حين قال في المقدمة: " إن
سيرة هذا الشاعر هي حرف أول في
أبجدية حياته" ( ص 32).
***
أما بداية كتاب الأنباري فهو
اتفاق يعقده مع القارئ ومفاده: أن
السيرة الشخصية غالبا تحدد توجهات
الكاتب، على الأقل من ناحية
الموضوع.
وعليه يرى أن أديب كمال الدين
مدين في كل كتاباته لحياته القلقة
وغير الآمنة والحزينة، وبالأخص
خلال الطور الثاني منها في المنفى
حيث يحاصر الإنسان نوعان من
المشاعر " الغربة والحنين".
لقد تركت هذه الحالة أثرا لا
تخطئه العين في القصائد، و التي
تنتقل دائما من الفجيعة إلى
الخسارة. ومن العذاب إلى الألم
المبرح. وبين المبتدأ والمنتهى
تتفاقم عدة إشكالات و منها السؤال
عن الماهية، وتجسيم شبح الموت،
وأعباء الغربة، بعد المرور بأعباء
الحرب والحصار ( ص 28 ).
ولذلك اعتمدت القصائد على أسلوبين
في التعبير: التكرار لأن عالم
الشاعر دائرة تحيط به ( ص 34 )،
وشخصنة العواطف ( ص 49 ) بمعنى
رسم بورتريه لشخص لديه عقدة تماثل
عقدة الشاعر.
**
ويوجد هناك ميثاق آخر يعقده
الأنباري مع غيره من النقاد. فهو
يتفق معهم على أهمية الحرف في
مسيرة الشاعر كمال الدين ( ص38).
ويلاحظ بيقظة شديدة تواتر هذه
الكلمة في عناوين القصائد ومتونها
وفي عناوين المجموعات أيضا. ولكنه
لا يشير لعلاقة ذلك مع سيرة
الشاعر. فهو جوهريا شاعر مؤمن.
ولا أشك لحظة واحدة أنه يحفظ عن
ظهر قلب أول كلمة نطق بها الوحي
وهي ( اقرأ ) للدلالة على أهمية
الفرق بين الماضي الوثني والحاضر
الإيماني. فالقراءة ( و بإبدال
رمزي تعني المعرفة والحرف) هي
الحد الفاصل بين الشرك والتوحيد.
وهي بنفس الوقت نفي وورقة ضد. زد
على ذلك أنها من خطوط العزل التي
تفصل ما بين الوجود و العدم.
فبالحرف يدخل الإنسان ميادين
الثقافة واللغة. وهذه ظاهرة هامة
حتى في التحليل النفسي. فاللغة
عند فرويد ( وبعده لاكان ) اختراع
أوديبي به يكتشف الطفل قانون الأب
و يكتشف ضرورة احترام المعايير.
ثم ضرورة الماهية الخاصة ومعنى
الحرية المشروطة.
***
أما أهم ما تطرق له الكتاب هو
المتشابه والمختلف في أشكال
ومعاني الموت عند أديب كمال
الدين. وقد صنفها ببراعة يحسد
عليها في ثلاثة أشكال: ما قبل
الموت وعند حده الفاصل وما بعده.
وكان المعيار هو الفترة التي تفصل
بين الحالتين: الوجود والعدم ( ص
121). ولكن لم أفهم كيف يكون
الشاعر من المتصوفة ويخاف من
الموت ويفكر به على الدوام. إن
أهم رموز التصوف في التاريخ
الإسلامي قد عاشوا حياتهم خارج
نطاق الزمان والمكان ولم يعترفوا
لا بالوقت ولا الجغرافيا وتعاملوا
مع أزمنة فلكية ونفسية ومع
جغرافيا لا وجود لها إلا في
تصوراتهم، وانطلاقا من هذه الفكرة
أرى أننا تجاه عدة إشكالات.
الأولى معنى الغيابة في الجب وشرح
صباح الأنباري لها بالاستناد
لمعناها الثابت الذي توارثناه
كابرا عن كابر. و بالعلاقة مع
حكاية سيدنا يوسف عليه السلام ( ص
46) . إن الإلقاء في الجب حدث
عابر له معنى دلالة. كالغيرة و
الحسد وطبيعة البشر التي تحل
المشكلة بالعنف والغدر. غير أن
الغيابة فيه تبدو لي أكثر تجريدا.
إنها جوهريا لا ترادف الموت. وفي
علم النفس ما بعد البنيوي (
ولنحتكم لجيل دولوز ) يكون للسقوط
في الفراغ ونحو الأسفل من شاهق
معنى الولادة اللامتناهية. وإن
رهاب أو حصر الأماكن المرتفعة
يعبر عن الرهبة من الولوج في
المرحلة المتحولة المجهولة. أو
الارتحال من معلوم ومنظور إلى
مجهول و غامض ( ولنضرب مثلا
بنموذج البورجوازي الصغير الأول
في تاريخ الخيال الفني وهو
روبنسون كروزو وقبله حي بن
يقظان). إن السقوط هنا لا يعادل
السقطة لأن الضحية بريء حقا. ولكن
قد يحتمل معنى الكمون. وبعبارة
أوضح إنه يدل على توقيف النشاط
الحيوي الطبيعي وتحريض النشاط
النفسي، ولنضع بعين الاعتبار
مسألة بغاية الأهمية تجد جذورها
في الفكر الباطني العَلَوي
وتفريعاته من توحيديين دروز
وإسماعيليين. إنهم جميعا مصدر
أساسي لحركات التصوف. حيث أن
الموت يعبر عن مساحة فارغة وتحل
محله فكرة التجسد والفيض والإحاطة
وأخيرا التقمص. ألم يخرج النبي
يوسف من البئر ويحكم مصر؟ لقد
كانت غيابته مجرد بشارة بولادة
لها تفصيلات أخرى فحسب. وعلم
الاجتماع السياسي هو فقط الذي
يتعامل مع هذه الحكاية على أنها
صراع على الحكم والثروات.
الإشكال الثاني. هو خيط قصة النبي
يوسف نفسها. إنها لا تتكرر في
القصائد فقط ولكن أيضا بين
المجموعات وبدأب غريب. وكأننا
حيال أحلام فرويد الذي لا تمر
عليه ليلة إلا ويحلم بيوسف.
وإن كانت التوراة ترى في القصة
رموزا جنسية فاضحة، و دراما
للصراع بين العفاف والغدر، فإن
الرابط مع القصائد مثل الرابط مع
التحليل النفسي. كلاهما يعزو
للنبي عليه السلام قوة لاشعورية
هي موهبة تفسير الأحلام.
وللتوضيح. كان فرويد والنبي يوسف
يهتمان بتفسير المنامات. أما
القصائد فهي تهرب من واقعها
وتفسره بواسطة اللاشعور الذي نعيد
تشكيله في تصوراتنا، أليس الشعر و
الفن عموما في نهاية المطاف نوعا
من حلم اليقظة؟
الإشكال الثالث. يدور حول رموز
أدوات الموت. هل هي واقعية أم
أنها متخيلة؟
لا
توجد و لو إشارة واحدة لهذا
الموضوع. مع أن شاعرا عمل على
تجسيد وشخصنة الحروف المجردة
والنقاط لا بد له من ترميز هذه
الموضوعات التي شغلت الذهن البشري
منذ أيام غلغامش وحتى أيام ماري
شيللي مؤلفة ( فرنكنشتاين). وغني
عن القول إنه توجد أكثر من صورة
في قصائد عديدة تعمل على أنسنة
ملاك الموت بشكل شاب يرتدي الثياب
السود، وخذ قصيدة ( حارس الفنار
قتيلا ) على سبيل المثال ( ص55).
ولكن هنا لا بد من الإشارة إلى أن
الثقافة الإسلامية في تاريخها
الطويل لم تحتكر اللون الأسود
ليدل لا على الحزن و لا الموت.
وهذه عادة تعزى للثقافات المسيحية
الغربية حيث يرتدي المعزون ربطة
عنق سوداء. وتجد ذلك في معظم
الأعمال الأدبية العالمية التي
ترزح تحت مظلة الموت. ومنها مثلا:
الغريب لكامو، والمرحوم لجيمس
جويس، و الموت يستأذن بالدخول
لوودي ألين وغيرها. ولا أرى غضاضة
من ربط رموز الموت عند أديب كمال
الدين برموزه في الثقافة
العالمية. وخير مثال قصيدته ( حلم
). فهي حلم فرويدي نموذجي وتتضمن
صورة لقطار أسود. وهو بنظر فرويد
إشارة لا محيد عنها للموت. وقد
انتبه الأنباري لذلك بفطنته
المعهودة ( ص 84).
على أية حال إن الخشية من الموت
موضوع متكرر في قصائد أديب كمال
الدين. وهو ليس دليل ادانة أو خوف
ولا هو حالة رعب مستفحل من
الشيخوخة. بمقدار إحساسه بالضعف
والوهن تجاه هذا العالم القاسي
القلب.
وهكذا تلتقي حالته الوجودية مع
تنامي مساحة الاغتراب لديه مع
ضعفه البشري الذي أصبح مادة
أساسية لمجمل أشعاره.
المشكلة الأخيرة وهي بخصوص
المصطلحات و المفاهيم. لقد استعمل
الأنباري بجدارة التحليل النفسي
مع التحليل الفني ( قراءة الأسلوب
ومعناه المستتر) . لذلك حصل لبس
في بعض المفردات. فهو مثلا في
قراءته لقصيدة جان دمو استعمل
الضمير الجماعي بمعنى رقابة الوعي
( 101). وهذا تضارب له ما يبرره.
وإن كنت أرى فعلا حاجة لوضع خط
أحمر تحت اللاشعور واختلافه عن
الرقابة. فالوعي هو الـ "
ego"
بينما اللاشعور هو الـ "
id".
وهذه هي حالة جان دمو. إنه يعيش
خلف حدود الرقابة. ولكنه رمز
للتمرد والعبث والسخط والاستياء.
ومثل هذه المشكلة تنتشر بسرعة
البرق لا سيما بعد تعدد المسميات
لجوهر واحد. فموت الإيديولوجيا و
موت التاريخ مثلا هما موت المؤلف
لو وضعنا بعين الاعتبار أننا نقرأ
النص خارج سياق تطوره. ولكن لا
يمكن أن ننظر للبنيوية و
التفكيكية على أنهما شيء واحد مع
أنهما من ضمن التيار العريض
للحداثة.
***
زد
على ما سبق عدة متوازيات في
المفاهيم والمعاني. وأشير هنا
لظاهرة التلازم بين ما يقول عنه
الأنباري التكرار ووحدة الجو
العضوي لتجربته مع الشعر. إن
التكرار لا يعني الرتابة والإضجار
( يسميه الأنباري الترهل - ص 72).
بل بالعكس، لقد كفانا مؤونة مثل
هذه الشبهات. فتشخيص الرموز
وأنسنة الحروف موضوع متكرر ولكن
بصور متبدلة. إنه لا فرق ، مثلا،
بين رومنسية عبدالحليم وكلاسيكية
أم كلثوم ووطنيات فيروز. كل شخصية
تشير إلى الكم الهائل من الضغينة
المتفشية في عالمنا المشوه
والمحكوم بقانون الرياء
والمداهنة. ضع في حسبانك صورة
السرير الوحيد ( في قصيدة فيروز )
ولواعج الروح والشوق والأسى في (
قصيدة المطربة الكونية) ( ص 72) .
ولكن هذا لا يمنع من وجود علامات
فارقة. وغني عن القول إن غزليات
نزار قباني بصوت عبدالحليم حافظ
لن تستعمل نفس الصور والرموز التي
تتوفر في شعرية أحمد رامي وبصوت
أم كلثوم. فما بالك لو انتقلنا
لخلفيات الحضارة المتوسطية التي
تتبناها فيروز بجدارة وتعيد
إنتاجها بصوت السبرانو الأوبرالي.
وقل نفس الشيء عن علاقة الخيال
الفني بالحياة. و كان الأنباري
مصيبا في أن الشخصيات الفنية هي
غير الشخصيات الموجودة بيننا ( ص
69 ). فالفن يعيد تفكيك و تركيب
الواقع المتكرر نفسه لتوضيح وجهة
نظره بطرق متباينة. ولو أنه اكتفى
بالنقل من الحياة لما كانت له
شخصية ولما كانت هناك ضرورة لمئات
بل آلاف القصائد التي تتحدث عن
الحرب والطغيان وغير ذلك. وإن
فكرة غارودي عن الواقع اللامتناهي
لا تتعارض مع مبدأ الإنطباعية
والتعبيرية في الفن. فالحياة
النفسية للشاعر أو الفنان لها
وجود مستقل عن حياته الإجتماعية.
ودائما للكاتب مطلق الحرية في
اختيار ما يراه وما يغمض عينه
عنه. إن رواية ( المستنبت الزجاجي
) لكلود سيمون تعيد بناء الذهن
المعاصر وتقدمه لنا بصورة مساحة
يتقاسمها الخيال والوهم والواقع.
وهذا هو حال هذه الباقة من
القصائد. إنها ترسم صورة مجملة
لكل جوانب الشخصية المعاصرة، التي
تتحرك على عدة محاور في نفس
الوقت. لقد أصبح الذهن الحديث مثل
الأدوات متعددة الوسائط. يرى من
خلف شروط المكان، ويعيش في عدة
عصور في نفس اللحظة.
حقا لم يكن الشاعر في أية قصيدة
ضمن إطار المحاكاة الكلاسيكي. حتى
قصائد الشخصيات الخيالية لم تنقل
عن الأصل. وأضرب قصيدة ( زوربا )
مثالا على ذلك. فهي تتحدث عن صراع
الشك والإيمان كما تفضل الأنباري
بالتوضيح ( ص 79)، مع أن كتاب
كازانتزاكيس يتكلم عن دور الرجولة
( الماشيزمو بالمصطلح النفسي ) في
ترويض الطبيعة وإعادة تأهيل
العلاقة بين السلطة والمجتمع.
***
أخيرا أرى أن الأنباري لم يتكلم
في كتابه عن فن الشعر فقط، ولكنه
كان جريئا في الكلام عن ظاهرة
الموت وأثرها على تشكيل العقل
الحديث. وقد ترك ذلك لمسة جمالية
على كتابه. فكما نعلم للموت رهبة.
إنه مثل الألغاز الطبيعية الأخرى
المحيرة التي لا يمكن البت
بشأنها، والتي دائما تتطلب المزيد
من التأمل والتفكير.