إنَّ كلّ قصيدة في شعر أديب
كمال الدين هي في حقيقتها جذوة
شخصية في كيان من اللهب الروحي
والشعري، ولا تتم كتابتها بعيدا
عن ذاكرة الشاعر، تلك البئر
الطافحة حتى القرار بمخزون لا
ينتهي من الأوجاع.
وقصائده تأتي من الذاكرة،
من منطقة بعيدة، يثوي فيها كل ما
هو طريّ ونديّ، ومع هذه الطراوة
والنداوة ثمة جروح غائرة بالوجع
تستعاد بما فيها من لهب كأنها
تتفتح الآن مع الألم، وتقطع
الطريق على النسيان.
فالشاعر وجد نفسه محاطا
بأوجاع تنهش انسانيته وتسحق
فرديته، وحياته تفرغ من روح
الانتماء الى الآخر بوشيجة
حقيقية، فهو يواجه حقيقته
المخيفة: عزلته وضعفه واحساسه
باللاجدوى، الحياة حافلة بالفواجع
التي جعلت من هذه الحياة مكابدة
دائمة.
ما دمتَ تسيرُ في الدنيا بلا
بوصلة،
فلماذا لا تجرّب
أنْ تكون بحّاراً في بحرِ النقطة
حدّ أنْ تطفو جثّتُك
فتُريح وتستريح؟
***
ما دمتَ وسطَ الزلزلة الكبرى،
قد نسيتَ اسمَكَ إلى الأبد،
فعلامَ تحاول أنْ تتذكر
حيث لا تنفع الذكرى؟
يقدم أديب كمال الدين في
هذا الديوان مشاهد ولقطات متتابعة
وسريعة يقتنصها من الحياة، من
مواقف وتجارب سريعة، ومن أسفار
ورحلات، ومن تعبيرات عن الغربة
والاغتراب، ومن محاولات لاستعادة
الزمن الماضي، يلوذ به الشاعر من
الأزمنة المتراكضة المتسارعة،
التي تغير الهوية، وتؤثر على
تأملات الذات ووعيها بالعالم، لذا
فإن تمثّل الزمن الماضي الشخصي،
والذكرى، وقراءة الوعي الزمني في
تجربة الحياة، هو ما يسعي الشاعر
إلى استعادته. إن شعره في معظمه
لا يعكس نفْساً متصالحة مع الخارج
أو محتفية به.
العنوان ينهض ومنذ بدايته،
بوظيفة مهمة تستبق مسار النص
وتوحي بدلالته التي يتمركز حولها،
ويحشد كيانه كلها، وكأنه يضمر
أسئلة عدة، سؤال السلطة، أم سؤال
الهيمنة، أم سؤال الحرية، أم سؤال
المسؤولية، وربما سؤال الأنوثة
والذكورة، أو سؤال التحول ...الخ،
فالأفق يزدحم بالمؤشرات.
تدور أغلب قصائد الديوان
حول همومه العربية، فالشاعر غارق
في مشكلات أمته، ولهذا نراه يغوص
في تحليل خريطة الهموم العربية،
واضعا في اعتباره كل المتغيرات
المؤثرة في واقعنا.
استعانت الذاكرةُ بالهلْوَسَات
لتنسجمَ مع خرابها الهائل.
...
استعانتْ شوارعُ الليلِ بخُطى
المُشرّدين
لتحافظَ على ذاكرتِها.
فالشاعر يتنفّس تاريخ
امته، ومن خلال هذه المعايشة
المستمرة للتاريخ فإنه يضع يديه
على جروح الأمة.
فتّشتُ بعينين دامعتين عن حاء
الحلم،
فتّشتُ أوراقَ قصائدي القديمة،
لم أجدْ إلّا حاء نوح
وحاء الحرمان
وحاء الحرب
وحاء الحنين.
بسرعةٍ أطلقتُ النارَ على حاء
الحنين
فأصبتُ مِنها مَقْتَلاً،
لأنني لا أملكُ ما أحنُّ إليه:
الفرات وقد تجاهلني،
ودجلة لم تتعرّفْ عليّ،
وكلكامش لم أجده في المتحف
كما كانَ الوعد.
...
ثُمَّ انتبهتُ إلى حاء الحرب،
كانتْ مُدمّاة مِن السرّةِ حتّى
العنق
في حروبِ الطاغيةِ التي طاردتني
بنجاحٍ عظيم
مِن يومٍ إلى آخر،
ومِن سنةٍ إلى أخرى،
ومِن دهرٍ إلى آخر.
ولم تتركني إلّا خشبة طافية
يتلاعبُ بها الموجُ على شاطئ
المُحيط.
نصوصه تستغرق أبعاد الهاجس
المؤلم، والمعبر عنه بهذا اليقين،
إزاحة إلى تراتيل البكاء،
والرثائيات الهادئة، التي تضع
"الهاجس/الموت" في مجابهة
الأسئلة، وتفارق بأسئلتها حتمية
الصبر، إلى قرارات النفس،
المطمئنة/الفاقدة.
هذا الموقف المتسائل إزاء
الفقد، يستبطن دخيلة الوجدان
المبتلي بعنف الفاجعة، والتي
تستولد الأسئلة البسيطة في
بداهتها. وتتوقف عندها دورة
الحياة ونظامها، وهي وإن تمادت في
قراءة ذاتها الموجوعة، ومن ثم
إستظهار أسئلتها الملحة، والتي لا
تجد إجابات تروي عطشها الدائم
والمستمر، وتكمن نباهتها في
استحالة إجابتها، فإنها تمضي في
سند كسرها بمزيد من الأسئلة، إذ
هي الهاجس المحرض على قراءة جبرية
الحياة وقهريتها.
اليوم سأذهبُ إلى البحر
....
سأحاولُ أنْ أحدّثه
عن آلامِ الحُروفيّ الذي هو أنا.
سأحاول،
فأنا متأكّدٌ أنّه لن يفهمَ هذه
الآلام.
فهو لا يفهم في الحروبِ والدمِ
والحصار،
لا يفهم في القتلِ والكراهيةِ
والخيانة.
البحرُ رجلٌ طيّبٌ ومُسالم.
البحرُ رجلٌ طيّبٌ ومُسالمٌ حَدّ
اللعنة.
لكنّه يفهمُ في الغرقى.
وبذلك تتعالى شعرية الموت
من كونه نهاية للحياة، إلى طبيعة
دينامية جديدة، وهي توليد
الأسئلة، وديمومة قراءة أسئلة
الموت، بما يشكل دلاليا اتصالا في
البنية الشعرية، يوازن بين قيمتها
الأولى المتمثلة بــ "العنوان"
إلى السياق الشعري.
وهي ترتقي هنا لتصبح بعد
زوالها دوالاً على نهاية الحياة
لذات الميت، لتتجلى شعرية الموت
من فرض هيبتها كحقيقة على التجربة
بجملتها، وتوائم بين معناها
"الحقيقي/الوجودي" ووجودها الآتي
في سياق شعري يستعضد دلالالتها
لتكثيف زخم مفردة الموت في سياقات
وتصاريف لغوية متعددة، عبر نصوص
الديوان.
وحينَ أعطيتُكِ شيئاً مِن السين،
أشرتِ عليَّ بأنْ أزرعها في أرضٍ
قاحلة
أو أرضٍ ذات عظام
أو أرضٍ ذات حُطام.
لم أكنْ شجاعاً بما يكفي
لأنفّذَ إشارتَكِ الكبرى.
خفتُ مِن دخولِ أرضِ العظام،
وخفتُ مِن دخولِ أرضِ الحُطام،
فآثرتُ سهولَ النسيان.
كيفَ يدخلُ إلى أرضِ الحُطام
مَن كانَ حُطاماً؟
كما أنها تلتقي في التعبير
عن مصير "الفاقد" ومستوى فجيعته،
وعدم تحرره من الهاجس. ومن ثم
التمادي بحقنه بالأسئلة الحتمية،
وبذلك يتأكد "الهاجس/الموت"
ويتجدد بتجدد ظروف استعارته من
عمق الحقيقة الإنسانية/الوجودية
إلى المستوى الشعري، الذي ينعطف
هنا عن مسار "التخييلية" التي
يعتبرها حازم القرطاجني معتبرة في
حقيقة الشعر عندما يحدد أن
"المعتبر في حقيقة الشعر إنما
التخييل والمحاكاة". ولعل المعتبر
ظهور "الموت" في كونه إحساسا
محضا، وحقيقة معاشه تنتصف
"التجربة" وتقتعد لها حيزا في
مسيرتها.
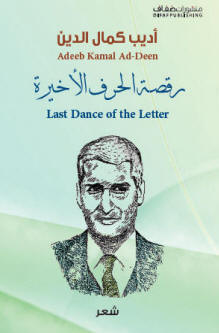
الشاعر يزرع في نفسه وجع
الأسئلة، ولا جدوى الإجابات، حيث
يطغى قاموس
"الانمحاء/الزوال/التحطّم" ويقترب
النص من تكوين لوحة مأساوية،
ينخفض بها صوت الخائف اللائذ
بملهاة الأسئلة المطمئنة. ويتنامى
الإحساس بالضجر، حدًا يستفز فيه
نواة الخوف من الموت، ويجذر
الإحساس بالأسى، بحيث يتمثل
الشعري/ إزاء الإنساني، في موقف
تبادل، يجسد فيه الإنسان الحقيقة
المطلقة، والشعري كبيان جمالي،
معبر عن الخوف، والقلق من القادم
المجهول.
الفضاءات الدلالية التي
تتعاقب في النص بتتابع مرحلي مبطن
بتشكيل تخييلي "لما بعد الموت"
حيث يصل منه إلى المعبر المتأمل،
الذي يتمثل في حركة "المابعد"
جزءا رئيسا في السياق الشعري،
يتلمس طاقاته الدلالية من خاصية
انبنائه على أجزاء الصورة
المرسومة، والمحكومة بصدقيتها،
وشفافية تأملها لنهاية الإنسان،
الفعل الإنساني مجردا من جماليات
الحياة وحيويتها. وماضيا إلى
نهايته، بحيث يصبح مفهوم التلقي
لمثل هذه الصورة مخاتلا لتوجه
الحواس نحو تكوين فضاء
"شعري/بصري" لذات تقرأ الموت
مجسدا خارج إطار معقوليتها
المعتادة، إلى استبطان نسق شعري
مسكون بالتوتر. والذي يحدد
مستويات الإدراك الإنساني الواعي
بمفهوم الموت والمنتهى إلى اليقين
الأبدي.
استعانَ المشنوقُ بحبلِ المشنقة
خوفاً مِن الجَلّاد.
استعانَ الغرقى بأسماكِ القرش
خوفاً مِن البحر.
استعانَ القبرُ بجُثّةِ الميّت
خوفاً مِن الزلزال.
....
استعانَ الدمُ بالسمّ
خوفاً مِن النزيف.
استعانَ القتيلُ بقاتله
خوفاً مِن الخوف.
الشاعر يقيم في توازنات
ومجازات ومعابر تضيء وتساعد على
إنضاج المعنى الجمالي، ونقل
رسالته من فجاجة المباشرة إلى لطف
الإشارة الكاشفة عن الأبعاد التي
يتقصدها الشاعر من شعره، فتتموقع
في النص بمثابة المفصل الذي يحرك
الباب المغلق لتنفتح أمام القارئ
مساحة أكبر وأرحب.
هي الفضاء التي تنشأ في
ظلال المعنى، وتتركز النواة
الدلالية موشومة بما كان يعتمل في
السطح، ويوصل إليها بوصفها العنصر
الجاذب والصيد الذي يغري، يداريه
الشاعر بقصد أو بغير قصد، ومن
جهته يقوم القارئ بالتقاط
الإشارات واقتناص الطرق الموحية
بما خلف الظلال.
فكيف تخرج من الواقعي
واليومي وتظل فيه؟ وكيف تخرق
المألوف والمعتاد وتبقى منغمسا في
طياته كأنك لم تخرق ولم تغادر؟
بقدر ما تغترب فأنت تقترب.
فالشاعر مسكون بمسألة
السلطة بطيفها المتعدد، وبقضية
الزمن بأثره الغائر في الشخصيات
والأمكنة، وكلاهما تشيران إلى
واقعة اجتماعية ملموسة لكنها
محيرة، تستنفر حاسة السؤال
والبحث، والتنقيب في وضع ملغّز
يفارق البداهة وتغيبه عتمة
التفاصيل، مما تحتاج معه إلى
طريقة تسعف في الاستنطاق والتأويل
على نحو جمالي.
رقصَ الأسرى وهم يدخلون وطنَهم
مِن جديد
وتلمّسوا بألمٍ
سلاسلَ أرقامهم المُعلّقة
على صدورِهم النحيلة.
...
رقصت المدينةُ السرّيّة
حينَ وصلَها الزائرُ المجهول.
...
رقصَ الخونةُ الليلَ كلّه
وهم يتبادلون نخبَ الخيانة.
والواقع المقاد بالسبب
والنتيجة، المغلول بالحتمية،
والمنطق المحكوم بالحواس، هذه
الحدود التي تسيج الواقع بقدر ما
تؤكد الحضور والوضوح، وبقدر ما
تخفي في الشقوق عالما كثيفا من
الغياب، يستعصي على النظرة
الجوّابة، يبقى منزويا في عتمته
الخاصة التي لا تبددها شمس
الحواس، ويحتاج لاستخراجه الى
طريقة تعانق الظل وتدلف الى السر،
تحاول فتحه والوقوع على مكنونه.
أردتُ أنْ أحتمي بكهفكِ الأسْوَد
فاكتشفتُ أنّه قطعة قماشٍ بلهاء
تطيرُ في مَهبِّ الريح.
...
أردتُ أنْ أغنّي أغنيتَكِ:
أغنية البراءةِ الأولى،
فاكتشفتُ أنَّ الأغنيةَ قصيرة
جدّاً
ولا تصلحُ لأيّ مقامٍ كان.
فالعلاقة بالماضي تشغل
حيزا كبيرا من أشعار الديوان،
الجرح الذي لم يندمل، ولا يفتأ
يفيض بأوجاع الحسرة، ظلال الذاكرة
تندى بزمن العمر الجميل فتثور في
القلب مشاعر الحنين إلى ما يصعب
نسيانه، ولا يسهل التخلص من حضوره
الضاري.
وفي بعض قصائده يورد أديب
كمال الدين أكثر من رمز تاريخي،
ويلاحظ أنه يستدعي رموزا من عصور
مختلفة، ويصبها جميعا في بوتقة
واحدة، وتكون النتيجة قصيدة
"عصرية" يتكشف فيها الماضي كله،
وتختلط همومنا القديمة بمآسينا
الجديدة.
يقيم الشاعر في ديوانه
جسورا من الحوار بين نصوصه ونصوص
شعراء آخرين، ينتمون إلى أزمنة
متباعدة وأمكنة مختلفة. والشاعر
لا يعيد علينا معاني الشعراء
الآخرين أو تراكيبهم، بل يحدّث في
تلك المعاني والأبنية إضافاته
وتحويراته الخاصة، ليجعل منها
جزءا من رؤياه الشخصية إزاء الكون
والحياة. ومعظم إيماءاته إلى
الشعراء السابقين لا تكتفي
باستخدام نصوصهم لتعزيز الشحنة
الوجدانية لنصه الجديد، أو تنمية
ما فيه من شجن عاصف، أو إحساس
غامر بالبهجة فقط، بل تخفي وراءها
موقفه الخاص من الشعر، وفهمه
لطبيعته وجدواه في هذا العالم. أي
أن تلك الإيماءات كانت تنهض بدور
كبير في بلورة موقفه الفكري
وتعميق رؤياه.
حينَ ماتَ ديكُ الجنّ
أورثني ديوانَ مراثيه الخطيرة
لحبيبته التي قتلَها في لحظةِ
شكٍّ وجنون.
ولأنّي أكرهُ المراثي كلّها
فقد أهديتُه
إلى أمينِ مكتبةِ المدينة،
فتصوّرهُ كتاباً عن الجنّ،
فرماهُ بوجهي وهو يصرخ:
خذْ كتابَكَ واخرجْ أيّها
المجنون!
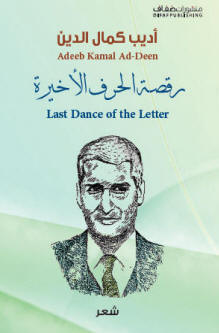
لعل إيماءات الشاعر إلى
الشعراء السابقين هي في حقيقتها
حوار مع رؤاهم أكثر منها استدراجا
لشذرات نصوصهم. بمعنى آخر، إن
حضور النصوص الشعرية لا يتحقق،
دائما، من خلال أواصر نصية، أو
تداخل لغوي بين النص القديم والنص
الجديد، لكن الشاعر يدرج النص
القديم في علاقة فكرية وانفعالية
مع النص الراهن.
والشاعر في إيماءاته لا
يقف عند الشعراء والكتّاب فقط، لا
يكتفي باستيحاء أفكارهم ورؤاهم،
بل يتجاوز ذلك كله إلى ما هو أبعد
منه، يتجاوز الزمن ممثلا بالبشر
والنصوص، ليدخل في خضم المكان،
وثرائه الدلالي، وينشئ بين نصوصه
وعناصر المكان وشيجة عامرة
بالفجيعة والحلم في آن واحد.
مطرُ بغداد،
قالت الغيمة،
اسمهُ: اللعنة.
مطرُ الفرات،
قالت الغيمة،
اسمهُ: الدمعة.
....
إذن، شكراً بغداد.
وصلتْ لعنتُك
وترجمتُها إلى سبعين لغة حيّة
ومُنقرضة.
شكراً للفرات.
وصلتْ دمعتُك
فحاولَ أنْ يسرقها مِنّي الشاعرُ
المُرائي.
وحينَ رفعتُ يديَّ إلى السماء
عادتْ إليَّ دمعتي
بعشراتِ القصائد الباكية.
فالشعر ومضات من أحاسيس
ومشاعر، وزخم من أفكار وهواجس
تقذفها المواقف والأحداث خارج
الذات الإنسانية، وذات الشاعر
تمتزج بالتاريخ فتشعر به وكأنه
يستقرئ كتب التراث، ثم يأخذنا نحو
الثقافة العربية الغنية برموزها
الحية، ليخرج لنا الماضي والحاضر
في صورة رمزية تعبيرية تهيم في
عالم الأساطير.
.............................
رقصة الحرف الأخيرة/ شعر:
أديب كمال الدين، منشورات ضفاف،
بيروت، لبنان
2015
........................................
نُشرت المقالة في جريدة
الدستور الأردنية 10 نيسان -
أبريل 2015